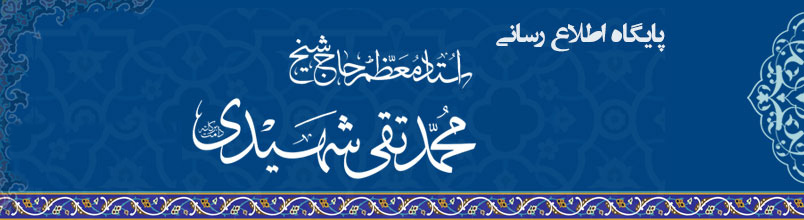وأورد عليه في تعليقة البحوث بأنّه في مثال «أکرم کلّ عالم إلا زیدًا» مع تردّده بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر، لم نقبل الظهور المشروط بكذب الظهور الآخر، -لما مرّ من أن الظهور لا يقبل التعليق والاشتراط- ولا الظهور في العنوان الانتزاعيّ، أي وجوب إکرام الفرد الآخر غیر المراد من المخصِّص؛ لما مرّ من أنّه ليس ظهورًا ثالثًا وراء ظهوره في وجوب إكرام زيد بن عمرو ووجوب إكرام زيد بن بكر، فلا بدّ أن يكون مشيرًا إلى العنوان التفصيليّ، والمفروض انتفاء الظهورين التفصيليّين، وهذا بخلاف ما إذا كان المخصّص المجمل منفصلًا، فهذه الثمرة تامّة في هذا المثال.
ويرد عليه ما مرّ منّا من أنّه لا وجه للإشكال في ظهور «أکرم کلّ عالم إلا زیدًا» في شموله للعنوان الانتزاعيّ، وهو عنوان «الفرد غير المراد من هذا المخصص»؛ فإنّ ظاهره أنّه لم يخرج عنه إلا فرد واحد، لا فردان. والظاهر انتفاء الإشكال حتى فيما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال واقع معيّن، كما لو قام الدليل على عدم وجوب إكرام زيد وعمرو معًا -كما مرّ توضيحه- فإذن لا تتمّ هذه الثمرة بين المخصّص المتصل والمنفصل.
ثمّ إنّ ما في البحوث من ذكر مثال العلم الإجماليّ بنجاسة الثوب أو الماء مع فرض استصحاب نجاسة الثوب، يرد عليه أنّ هذا المثال خارج عن محل البحث أساسًا؛ فإنّ المقيّد اللبّيّ المتصل، سواء كان حكم العقل أو ارتكاز العقلاء، لا يوجب خروج خطاب الأصل الترخيصيّ عن الطرف الذي يكون التكليف في طرفه الآخر متنجّزًا بمنجّز تفصيليّ حاكم على الأصل الترخيصيّ فيه؛ وعليه، فلا يكون خطاب الأصل بالنسبة إلى الطرف الذي لا يجري فيه أصل مؤمّن مبتلًى بالإجمال أبدًا، فلا وجه لعدّ هذا المثال من أمثلة إجمال المخصّص.
الثمرة الثانية: إذا ورد «أكرم كلّ عالم إلا زيدًا» وتردّد بين كونه زيد بن عمرو أو زيد بن بكر، وورد عام آخر ينفي بعمومه وجوب إكرام زيد بن عمرو، كما لو كان فاسقًا وورد في خطاب: «لا يجب إكرام أيّ فاسق» فهذا العام الثاني يكون حجة بلا معارض لنفي وجوب إكرام زيد بن عمرو؛ لأنّ المجمل لا يعارض المبيّن، ولازم حجيّة العام الثاني بضمّ العام الأول هو وجوب إكرام زيد بن بكر، بينما أنّه لو كان المخصّص المجمل منفصلًا عن العام، كما لو قال «أكرم كلّ عالم» ثمّ ورد في خطاب منفصل: «لا تكرم زيدًا» وتردّد بين زيد بين عمرو وزيد بن بكر، فتقع المعارضة بالعموم من وجه بين قوله: «أكرم كلّ عالم» مع قوله: «لا يجب إكرام أيّ فاسق» بلحاظ شمولهما لزيد بن عمرو، في عرض المعارضة الداخليّة بين ظهور «أكرم كلّ عالم» في شموله لزيد بن بكر وبين ظهوره في شموله لزيد بن عمرو نتيجةَ ورود المخصص المنفصل، فهذا الظهور الأخير طرف للمعارضة مع كلّ من ظهور «إكرام كلّ عالم» بالنسبة إلى زيد بن بكر، وظهور «لا يجب إكرام أيّ فاسق».
ومن هذا القبيل ما لو علمنا إجمالًا بنجاسة ثوب أو ماء، فحيث إنّ قاعدة الطهارة خطاب مشترك لكِلا طرفي العلم الإجماليّ، بينما أنّ قاعدة الحلّ خطاب مختص بالماء، فإنّ نجاسة الثوب ليست موضوعًا لحكم تكليفيّ، وإنّما هي موضوع لحكم وضعيّ، وهو بطلان الصلاة فيه، بخلاف نجاسة الماء؛ فإنّها موضوع لحرمة الشرب تكليفًا، فتجري فيه قاعدة الحلّ.
وقد حكم السيد الخوئيّ؟ق؟ فيه بجريان قاعدة الحلّ بلا معارض؛ لكونه خطابًا مختصًّا بأحد طرفي العلم الإجماليّ، فلا يعارضه قاعدة الطهارة في الثوب؛ لكون قاعدة الطهارة خطابًا مشتركًا بين طرفي العلم الإجماليّ، فتكون مبتلاة بالمعارضة الداخليّة، وهي العلم الإجماليّ بتخصيصها في أحد الطرفين على الأقل.
وفيه: أنّه بناءً على مسلكه من كون محذور جريان الأصول الترخيصيّة في أطراف العلم الإجماليّ بالتكليف، وهو قبح الترخيص في المخالفة القطعيّة، بمثابة المقيّد المنفصل؛ لعدم كونه مستفادًا من الحكم البديهيّ العقليّ، بل من الحكم العقليّ النظريّ، فلا يمنع من انعقاد ظهور خطاب الأصل في شموله لأطراف العلم الإجماليّ، وإنّما يمنع من حجيّته، وقد ذكرنا في محلّه أنّه بناءً على هذا المسلك، فمجرد ابتلاء الخطاب المشترك -وهو قاعدة الطهارة في المثال المذكور- بالمعارضة الداخليّة أي العلم الإجماليّ بعدم جريانه في أحد الطرفين لا يوجب سلامة الخطاب المختص بأحد الطرفين، أي قاعدة الحلّ في الماء عن المعارضة مع الخطاب المشترك بلحاظ شموله للطرف الآخر؛ فإنّ العلم الإجمالي بكذب ظهور قاعدة الحلّ بالنسبة إلى هذا الماء أو كذب ظهور قاعدة الطهارة بالنسبة إلى الثوب يوجب تعارضهما في الحجيّة في عرض معارضة هذا الظهور الثاني مع ظهور قاعدة الطهارة بالنسبة إلى الماء، فيسقط الجميع عن الحجيّة في عرض واحد.
وهذا بخلاف ما لو قلنا بما هو الظاهر من انصراف خطاب الأصل الترخيصيّ المشترك عن أطراف العلم الإجماليّ؛ لكونه مخالفًا للمرتكز العقلائيّ؛ فإنّه حينئذٍ لا ينعقد له ظهور في شموله لأطراف العلم الإجماليّ فلا يوجد معارض لظهور الخطاب المختص، بل يكفي في ذلك شبهة الانصراف.
ثمّ إنّه بعد ما جرَت قاعدة الحلّ في الماء، فقد يقال بأنّه يكشف عن عدم جريان أصالة الطهارة في الثوب؛ حيث يلزم من جريانهما معًا الترخيص في المخالفة القطعيّة، فإطلاق دليل قاعدة الحلّ في الماء ينفي جريان أصل الطهارة في الثوب؛ فإن قلنا بجريان أصالة العموم في دليل قاعدة الطهارة لنفي تخصيص الثوب والماء معًا عنه، وإنّما يكتفى بمقتضى المخصّص اللبّيّ المتصل بخروج أحدهما عنه فقط، فكان يثبت بذلك جريان أصل الطهارة في أحدهما، فبضمّ ذلك إلى إثبات عدم جريانه في الثوب نحرز أنّ الذي كان يجري فيه أصل الطهارة هو الماء، وأثره إمكان الوضوء منه.
وأجيب عنه بأنّ التضادّ لا يكون بين قاعدة الحلّ في الماء وأصالة الطهارة في الثوب، إنّما يكون بين وجودهما الواصل إلى المكلّف؛ فإنّه لو جعلت أصالة الطهارة في الثوب، ولكن كان هناك مانع آخر عن وصولها إلى المكلّف غير معارضتها مع قاعدة الحلّ في الماء، وهو معارضتها مع أصالة الطهارة في الماء، فلا يكون هناك ارتكاز عقلائيّ في كون الجمع بين جعلها مع جعل قاعدة الحلّ في الماء نقضًا للغرض من التكليف المعلوم بالإجمال؛ لعدم استلزامها للترخيص المؤثّر في مخالفته القطعيّة، فلا يمكن إحراز عدم جريان أصالة الطهارة في الماء، بواسطة جريان قاعدة الحلّ، حتى يرتفع المانع عن جريان أصالة الطهارة في الماء.
وفيه: أنّ المانع عن جريان أصالة الطهارة في الثوب لو كان مانعًا آخر في رتبة سابقة عن جريان أصالة الطهارة في الماء تمّ ما ذكر، لكنّ المفروض أنّ المانع هو نفس الارتكاز العقلائيّ في كون الجمع بينها وبين أصالة الطهارة في الماء نقضًا للغرض من التكليف المعلوم بالإجمال.
هذا، والمهم أنّ الظاهر عندنا انصراف دليل الأصل الترخيصيّ المشترك بين طرفي العلم الإجماليّ عن الشمول لهما أو لأحدهما، فلو فرض العلم التفصيليّ بعدم جريانه في الطرف الآخر للعلم بعدم مزيّة له، واحتمل وجود مزيّة في الطرف الذي نريد إجراءه فيه، كما لو علمنا بنجاسة أحد ماءين وكان أحدهما مظنون النجاسة والآخر موهوم النجاسة؛ فإنّه لا يصح بنظرنا التمسك بدليل الأصل لإثبات جريانه فيه -حتى مع قطع النظر عن إطلاق قوله؟ع؟ في الماءين المشتبهين: «يُهريقهما ويتيمّم»- بل هو منصرف عنه، كما أنّه لو باع الموكّل داره من زيد وباعها وكيله في نفس الوقت من عمرو؛ فإنّه وإن كان لا يحتمل صحة بيع الوكيل، دون الموكّل، ولكن يحتمل صحة بيع الموكّل؛ لكونه هو الأصيل، دون الوكيل؛ ولكنّ الظاهر أنّ دليل نفوذ البيع منصرف عن بيعين متضادّين في وقت واحد رأسًا، ولا ينافي ذلك جريان أصل الطهارة مثلًا لنفي نجاسة الماء الثاني غير الماء المعلوم بالإجمال نجاسته؛ فإنّه لا إشكال فيه أبدًا، كما سبق توضيحه.
الثمرة الثالثة: ما يقال من أنّه إذا ورد «أعط زکاتك لکلّ فقیر لیس من مواليك وأبناء عمومتك»، فحيث يحتمل كون المراد من الموالي العبيد، فلا يحرز ظهوره في جواز إعطاء الزكاة للعبيد، بينما أنّه لو كان النهي عن إعطاء الزكاة للموالي منفصلًا عن العام، فحيث يحتمل كون المراد به أبناء العمّ، والمفروض العلم بتخصيصه، فلا يحرز تخصيص العبيد عن العموم.
التنبيه الثالث
المراد من المخصّص المنفصل المجمل المردّد بين الأقل والأكثر الذي حكمنا بجواز التمسك بالعام في المقدار المشكوك منه هو ما كانت النسبة بين المفهومين المحتملين فيه نسبة العموم والخصوص المطلق خارجًا، سواء كانت النسبة بين نفس المفهومين نسبة الأقل والأكثر المفهوميّ -كما لو شك في كون لفظ الفاسق موضوعًا لمعنى «مرتكب المعصية» أو لمعنى «مرتكب المعصية الكبيرة»- أو كانت النسبة بينهما نسبة التباين المفهوميّ، كما لو لم نعلم أنّه موضوع لمعنى «العاصي» أو «الظالم».
وما قد يقال في الفرض الثاني بأنّ أصالة عدم تخصيص مفهوم «العاصي» تتعارض مع أصالة عدم تخصيص مفهوم «الظالم»، فلا يمكن الرجوع إلى عموم «أكرم العالم» بالنسبة إلى «العاصي غير الظالم»، فيرد عليه: أنّ أصالة عدم التخصيص وإن كانت من الأمارات والأصول اللفظيّة، وتكون مثبتاتها حجّة عند المشهور، فلازم أصالة عدم تخصيص العام بمفهوم «الظالم» بناءً على جريانها تخصيصه بمفهوم «العاصي»، فتتعارض مع أصالة عدم تخصيصه بمفهوم «العاصي»، لكن حيث إنّ الملحوظ عند العقلاء هو المصاديق، والنسبة بين مصاديق «العاصي» و«الظالم» العموم والخصوص المطلق، فيرى مفروغيّة تخصيص «الظالم» من العام، ويشك في التخصيص الزائد، أي تخصيص «العاصي غير الظالم»، فتجري أصالة عدم تخصيصه عن العام.
ويُشهد ذلك بملاحظة سيرة العقلاء، كما لو دلّ دليل على وجوب إكرام كلّ عالم، وعلم أنّه إمّا ورد عن المولى «لا تكرم العالم المشرك» أو ورد عنه «لا تكرم العالم الكافر» فلا يرى العقلاء معذوريّة المكلف لو ترك إكرام العالم الكتابيّ، وهكذا لو علم بأنّه إمّا خصص بالعالم المخالف، أو العالم الناصب؛ نعم، لو كانت النسبة بين المعنيّين المحتملين للمخصّص المجمل هي التباين، كما لو قال: «تصدّق على كلّ فقير» ثمّ ورد عنه: «لا تكرم مواليك ولو كانوا علماءً»، وتردّد معنى الموالي بين العبيد أو الأرحام، أو كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه، كما لو فرضنا في هذا المثال كون بعض الأرحام عبيد؛ فإنّه لو كان أحد المتباينين أو مورد افتراق أحد العامّين من وجه خارجًا عن محلّ ابتلاء مكلف بأن لم يكن له في هذا المثال عبد أبدًا، فلا يمنع ذلك من معارضة أصالة عدم تخصيص العام بالنسبة إلى كلّ منهما مع أصالة العموم بالنسبة إلى الآخر.
وهذا هو الفارق بين هذا الأصل اللفظيّ، وبين الأصول العمليّة. فلو علم إمّا بنجاسة ما في يده أو نجاسة ما في يد شخص آخر ممّا يكون خارجًا عن محلّ ابتلائه، فتجري قاعدة الطهارة واستصحابها فيما تحت يده بلا معارض؛ لعدم أثر عمليّ لجريانها في الطرف الآخر.
الجهة السادسة: التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص
إذا كان المخصّص متصلًا بالعام، فمن الواضح أنّه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة لهذا المخصّص المتصل؛ إذ المخصّص المتصل يوجب تضييق ظهور العام، فينعقد ظهور العام في غير مقدار التخصيص، فيكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة لنفس العام، ومن الواضح عدم جوازه. فلو شكّ في كون زيد عالمًا، فلا يمكن التمسك بخطاب «أكرم كلّ عالم» لإثبات وجوب إكرامه؛ لأنّ إثبات وجوب إكرامه بواسطة كبرى وجوب إكرام العالم متوقف على إحراز كونه صغرى لهذه الكبرى؛ فإنّ الكبرى والقضيّة الحقيقيّة ليست ناظرة إلى إثبات وجود موضوعها وعدمه.
وإن شئت قلت: إنّ مآل كلّ قضيّة حقيقيّة إلى قضيّة شرطيّة شرطها وجود الموضوع وجزاؤها ثبوت المحمول له، ومن الواضح أنّ القضيّة الشرطيّة لا تبيِّن وجود شرطها في الخارج وعدمه.
إنّما الكلام والإشكال فيما إذا كان المخصّص منفصلًا. فقد حكي عن المشهور بين القدماء لزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل، كما نسب ذلك إلى صاحب العروة؟ق؟، حيث ذكر أنّه إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، وشك في أنّه من المستثنيات -كدم الحيض- أم لا، يبني على العفو. وأمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ، فالأحوط عدم العفو، إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلّيّة وشكّ في زيادته.
وليس وجه كلامه الأول إلا التمسك بعموم الدليل الدال على نفي البأس بالصلاة في الدم الأقل من الدرهم في الشبهة المصداقيّة لمخصّصه المنفصل الدال على مانعيّة دم الحيض، ولو كان أقلّ من الدرهم، وكذا ليس وجه كلامه الثاني إلا التمسك بدليل مانعيّة الدم للصلاة في الشبهة المصداقيّة لمخصّصه المنفصل، وهو العفو عن الدم الأقل من الدرهم.
وأجاب عنه السيد الخوئيّ؟ق؟ بأنّه يحتمل أن يكون وجه فتواه بالعفو عن الدم المشكوك كونه دم الحيض هو التمسك باستصحاب عدم كون ذلك الدم حيضًا بنحو استصحاب العدم الأزليّ، فيحرز بذلك موضوع العفو؛ حيث إنّ موضوعه هو الدم الأقل من الدرهم الذي ليس دم حيض، كما يحتمل أن يكون وجه فتواه هو التمسك بأصالة البراءة عن مانعيّة هذا الدم للصلاة، بعد ما لم يمكن التمسك بدليل لفظيّ من جهة كون الشبهة مصداقيّة.
وأمّا في الصورة الثانية، فيحتمل أن يكون وجه احتياطه بعدم العفو هو استصحاب عدم كون هذا الدم أقلّ من درهم، نظرًا إلى أنّ عنوان المخصّص عنوان وجوديّ، فلا مانع من التمسك بأصالة عدمه عند الشك فيه، فليس وجهه التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل.
أقول: ما ذكره من عدم كون مسلك صاحب العروة؟ق؟ جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة، وإن كان صحيحًا، لكن ليس وجه فتواه في الدم المشكوك هو ما ذكره من التمسك باستصحاب العدم الأزليّ؛ لمخالفته في العروة مع نتيجة هذا الاستصحاب في مسائل مختلفة، بل لقاعدة المقتضي والمانع. وقد صرّح بذلك في بحث النكاح، فقال إنّه إذا شك في كون المنظور إليه مماثلًا أو محرمًا أم لا، فيحرم النظر إليه، لا لأجل التمسك بعموم حرمة النظر في الشبهة المصداقيّة لمخصّصه المنفصل الدال على جواز النظر إلى المماثل أو المحارم، بل لاستفادة شرطيّة الجواز بالمماثلة أو المحرميّة، فالمقام من قبيل المقتضي والمانع.
وكيف كان، فقد يذكر لجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل مطلقًا عدّة تقريبات:
التقريب الأول: إنّ المخصّص المنفصل حيث لا يهدم ظهور العام في شموله لكلّ فرد من أفراد العام، وإنّما يوجب انهدام حجيّة ظهوره في مورد التخصيص لكونه حجة أقوى بالنسبة إليه، فلا موجب لرفع اليد عن حجيّة العام إلا في ما يكون المخصّص المنفصل حجة فيه، وليس المخصص المنفصل حجّة إلا في ما علم كونه صغرًى له؛ فإنّه لو ورد في خطاب المخصّص المنفصل: «لا تكرم العالم الفاسق»، فإنّه لا يكون حجّة وقاطعًا للعذر في شبهته المصداقيّة، أي إكرام من يشكّ في كونه عالمًا فاسقًا، ولذا تجري البراءة عن حرمة إكرامه.
وقد أجاب عنه السيد البروجرديّ؟ق؟ بأنّ وظيفة المولى بيان الحكم الكلّيّ، وكبرى الجعل وتشخيص انطباقه على المصاديق ليس من وظائف المولى، ومن هنا منعنا عن جريان البراءة العقليّة في الشبهات الموضوعيّة، بعد أن كان البيان من قبل المولى تامًّا.؛ ولکن قياس الحجّة في المقام بالحجّة التي تمنع عن جريان البراءة العقليّة قياس مع الفارق؛ فإنّ المانع عن جريان البراءة العقليّة هو الحجّة على التكليف الفعليّ؛ فإنّ مجرد قيام الحجّة على الكبرى، أي حرمة إكرام العالم الفاسق، مع الشك في الصغرى، أي كون زيد مثلًا عالمًا فاسقًا، لا يرفع موضوع البراءة العقليّة في حرمة إكرام زيد؛ فإنّ موضوعها عدم قيام الحجّة على حرمة إكرامه.
وأمّا المانع عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل، فهو قيام الحجّة على كبرى الجعل؛ فإنّه إذا ورد: «لا تكرم العالم الفاسق» فيكشف عن ضيق المراد الجدّيّ في قوله: «أكرم كلّ عالم» واختصاصه بوجوب إكرام العالم الذي ليس بفاسق، فلا يفترق عن قوله: «أكرم كلّ عالم ليس بفاسق» إلا في أنّ انكشاف تمام المراد الجدّيّ فيه يكون بتعدد الدالّ والمدلول. وحينئذٍ فلا يكون العامّ حجّة في الفرد المشكوك بعد انكشاف اختصاص المراد الجدّيّ منه بالعالم الذي ليس بفاسق؛ نعم، لو كان الخارج من العام هو المعلوم الفسق أمكن التمسك به في العالم مشكوك الفسق، ولكنّه ليس كذلك؛ لكون العنوان ظاهرًا في ما يشمل أفراده الواقعيّة معلومة كانت أو مجهولة.
وإن شئت قلت: إنّ وجوب الإكرام الذي يراد إثباته في الفرد المشكوك إن كان مطلقًا من حيث عدالته وفسقه، فهو خلف ما ثبت بالمخصّص من أنّ المولى لا يرضى بإكرامه على تقدير فسقه، وإن كان مشروطًا بعدالته، فإثبات الوجوب المشروط لا يجدي ما لم يحرز تحقّق شرطه.
التقريب الثاني: ما ذكره المحقق العراقيّ؟ق؟ ثمّ أجاب عنه، وحاصل ما ذكره هو أنّ التخصيص ليس كالتقييد موجبًا لتعنون موضوع العام بنقيض موضوع الخاص؛ فإنّ شأن التخصيص إنّما هو مجرد إخراج بعض الأفراد أو الأصناف عن تحت حكم العام، من دون اقتضائه لإحداث عنوان وجوديّ أو عدميّ في موضوعيّة الأفراد الباقية للحكم، بل هذه الأفراد الباقية بعد التخصيص تكون على ما كانت عليها قبل التخصيص في الموضوعيّة للحكم العام بخصوصيّاتها الذاتيّة، فالتخصيص بمنزلة موت بعض أفراد العام، في أنّ خروج من مات منها لا يوجب تعنون الأفراد الباقية بعنوان وجوديّ أو عدميّ، فكذلك التخصيص، ومجرد اختصاص حكم العام في قوله: «أكرم كلّ عالم» بعد التخصيص بغير دائرة الخاص لا يكون من جهة تعنون الأفراد الباقية بعنوان خاص، بل من جهة ما في نفس الحكم من القصور الناشئ من جهة تضيّق دائرة الغرض والمصلحة عن الشمول ثبوتًا لغير الأفراد الباقية.
وهذا بخلاف باب تقييد المطلقات، كقوله: «أكرم العالم»؛ حيث إنّ قضية التقييد تعنون موضوع الحكم بوصف غير حاصل قبل توصيفه به، ومن ثَمّ لم يتوهّم أحد جواز التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة للمقيّد المنفصل، مع أنّ في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصص المنفصل خلافًا بين الأعلام، بل قيل إنّ المشهور من القدماء جوازه، ومن المعلوم أنّه لا يكون الوجه في ذلك إلا ما أشرنا إليه من الفرق بين البابين.
ثمّ إنّ هذا كلّه في بيان الفرق بين البابين بحسب مقام الثبوت.
وأمّا بحسب مقام الإثبات واستظهار أنّه أيّ مورد من باب التخصيص وأيّ مورد من باب التقييد؟ فلا بدّ من المراجعة إلى لسان الأدلة؛ فما كان منها بلسان الاستثناء ولو المتصل، كقوله: «أكرم العلماء إلا زيدًا» فلا إشكال في أنّه من باب التخصيص؛ حيث إنّه لا يستفاد منه أزيد من إخراج زيد عن العموم، وحصر حكم العام بما عداه، كما أنّ ما كان منها بلسان الاشتراط، كقوله: «يشترط أن يكون كذا» أو بلسان نفى الحقيقة، كقوله: «لا صلاة إلا بطهور» فلا إشكال أيضًا في كونها من باب التقييد.
وأمّا ما كان منها بلسان «لا تكرم العالم الفاسق»، كما هو الغالب في المخصّص المنفصل، فهو قابل لكلا الأمرين. وحينئذٍ، فقد يدّعي قال في مثله بدوران الأمر بين رفع اليد عن أحد الظهورين، إمّا ظهور عنوان الموضوع في الإطلاق، أي كونه تمام الموضوع للحكم، لا جزأه، وإمّا ظهور العام في العموم. فإمّا أن يكون المتعيّن في مثله هو رفع اليد عن ظهوره في الإطلاق مع الأخذ بظهوره في العموم، أو يتصادم الظهوران، فتكون النتيجة حينئذٍ كالتقييد في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص. ولكنّه مندفع بمنع الدوران بينهما؛ فإنّه بعد القطع بخروج أفراد الفسّاق عن دائرة حكم العام، إمّا رأسًا على التخصيص، وإمّا من جهة انتفاء القيد على التقييد، فلا جرم لا يترتب أثر عمليّ على أصالة العموم بالنسبة إليهم، حتى يجري العموم بلحاظه، فتبقى أصالة الإطلاق بلا معارض. ونتيجة ذلك قهرًا هو التخصيص، لا غير، كما هو واضح.
وحينئذٍ، فبَعد عدم انقلاب عنوان العام عن كونه تمام الموضوع للحكم إلى جزء الموضوع، فلا جرم يكون أصل تطبيق العنوان على الشبهة المصداقيّة للمخصّص جزميًّا، فيتجه الاستدلال للقول بالجواز، بتقريب أنّه بعد الجزم بانطباق عنوان العام على المورد واحتمال مطابقة ظهوره للواقع في الزائد عن الأفراد المعلومة الفسق، ولو من جهة احتمال كونهم عدولًا، يشمله دليل التعبّد بالظهور؛ فإنّ المدار في التعبّد بالظهور إنّما هو على مجرد احتمال مطابقة الظهور للواقع.
وتوهّمُ اختصاص حجيّة الظهور بما لو كان الشك في مخالفة الظهور للواقع من جهة الشبهة الحكميّة، دون الشبهة الموضوعيّة، بدعوى أنّ الرجوع إلى أصالة الظهور إنّما هو في الشبهات التي كان رفعها وإزالتها من شأن الشارع، دون غيرها ممّا ليس من شأن المتكلم إزالتها، وبذلك ينحصر حجيّة الظهور في موارد الشبهات الحكميّة، ولا تعمّ الشبهات المصداقيّة، نظرًا إلى عدم كون إزالتها من شأن الشارع، فمندفعٌ بأنّه وإن كان الأمر كذلك بالنسبة إلى كلّ شبهة شخصيّة على التفصيل؛ ولكنّه لا مانع من جعل أمارة كلّيّة لتمييز الموارد وتشخيص الصغريات؛ فإنّ ذلك أيضًا من شأن الشارع، ولذلك شرّع قواعد في الشبهات الموضوعيّة، كقاعدة اليد عند الشك في الملكيّة.
ثمّ أجاب المحقق العراقيّ بنفسه عن هذا الوجه بأنّه إنّما يتمّ لو كان مدار الحجيّة في الظهورات على الدلالة التصوريّة المحضة التي هي عبارة عن مجرّد تبادر المعنى؛ ولكنّ التحقيق كون مدار حجيّة الظهور على الدلالة التصديقيّة والكشف النوعيّ عن المراد. ويختص حصول التصديق النوعيّ بمراد المتكلم من اللفظ بما إذا كان هناك غلبة نوعيّة على التفات المتكلم بجهات مرامه وخصوصيّاته، ففي الشبهة المصداقيّة للمخصّص، حيث لا يكون هناك غلبة نوعيّة على التفات المتكلم، بل ربما كان الأمر بالعكس، من حيث كون الغالب هو غفلة المتكلم وجهله بالحال، بشهادة ما نرى من وقوع التردّد والاشتباه كثيرًا للمتكلم في تطبيق مرامه على الصغريات، فلا يكاد يحصل التصديق النوعيّ بمراده حتى يكون مشمولًا لدليل الحجيّة.
والحاصل أنّه بعد اقتضاء الدليل المخصّص لاختصاص حكم العام بما عدا مورد التخصيص، فيشك في انطباق ما هو المراد الواقعيّ على الشبهة المصداقيّة، وفي مثله لا يبقى مجال لتوهّم جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل.
وما ذكره في الجواب متين، مضافًا إلى ما سيأتي من اقتضاء التخصيص لتعنون موضوع الحكم في العام بنقيض عنوان الخاص.
وقياسه بموت بعض الأفراد قياس مع الفارق؛ لأنّ موت بعض الأفراد موجب لارتفاع الحكم الفعليّ الذي هو معلول وجود الموضوع خارجًا، وارتفاعه لا يؤثّر في الجعل الذي هو مرتبط بمراد المولى، بخلاف التخصيص؛ فإنّه يتنافى مع بقاء موضوع الجعل في العام على عمومه، فيكشف المخصّص عن تقيّد موضوع العام ثبوتًا. وحينئذٍ، فيكون انطباقه على الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل مشكوكًا، فلا يمكن التمسك فيه بالعام.
التقريب الثالث: ما يتحصل ممّا ذكره في البحوث من أنّه في قوله: «أكرم كلّ عالم» -مثلًا-، وتخصيص العالم الفاسق بالمخصّص المنفصل، فوجوب الإكرام الذي يراد إثباته في الفرد المشكوك، وإن لم يكن مطلقًا من حيث عدالته وفسقه، لكونه خلاف ما ثبت بالمخصّص أنّ المولى لا يرضى بإكرامه على تقدير فسقه، بل هو مشروط بعدالته، إلا أنّ العام متكفّل لإثبات وجوب إكرامه فعلًا، وهذا يكشف عن تحقّق شرط هذا الوجوب المشروط في هذا الفرد، فهذا العام، حيث يدل بعمومه على وجوب هذا الفرد، فهو في قوّة أن يقول المولى: «أكرم هذا الفرد» ونعلم بأنّه لا يأمر بإكرام الفاسق؛ فإنّه يكشف عن عدالته.
وإن شئت قلت: إنّ العامّ إن كان يدل بعمومه على وجوب إكرام هذا الفرد من العالم المشكوك فسقه بمناط أنّه عالم، فهذا ينافي دلالة خطاب المخصّص من دخل العدالة في وجوب إكرامه؛ لكن ليس مفاد العام ذلك، وإلا لزم عدم حجيّة العام في المقدار الباقي بعد التخصيص، أي إكرام العالم العادل؛ للعلم بكذب دلالة العام على وجوبه بمناط كونه عالمًا؛ حيث ثبت بالمخصّص عدم كونه تمام المناط في وجوب الإكرام، ولا مقتضي لظهور آخر فيه.؛ وعليه، فليس مفاد العام إلا الوجوب الفعليّ لإكرام هذا الفرد من العالم، ويجتمع مع كون تمام المناط فيه كونه عالمًا، أو كونه عالمًا عادلًا، فهذا الوجوب الفعليّ ممّا لا ينفيه المخصّص؛ إذ غاية ما يدل عليه اشتراط وجوب إكرامه بعدالته، ونحن نحتمل تحقّق هذا الشرط فيه، وهذا يعني جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل. وبذلك تبيّن نكتة الفرق بين العام والمطلق؛ حيث إنّه توجد للعام دلالات عديدة بعدد كلّ فرد فرد، فإخراج أيّ فرد حتى الفرد المشكوك يكون تخصيصًا زائدًا على العام، بينما أنّه لا توجد في المطلق إلا دلالة واحدة على حكم الطبيعة.
وأجاب عنه في البحوث بما محصّله بتقريب منّا أنّه بعد ثبوت اشتراط وجوب إكرام هذا الفرد بعدالته، فإثبات وجوب إكرامه فعلًا يكون بأحد نحوين، كلاهما غير محتمل:
أوّلهما: أن يتصدّى المولى بنفسه في خطاب العام لإحراز عدالته، وهذا خلف كون العام قضيّة حقيقيّة، فلا يمكن عادةً للمولى بما هو مولى -لا بما هو عالم الغيب؛ حيث لا يظهر من الخطاب ذلك- إحراز حصول الشرط في الأفراد الخارجيّة مع كونها غير محصورة، ولا أقلّ بلحاظ الأفراد غير المحقّقة الوقوع فعلًا، وكذا خلف مفاد خطاب المخصّص المنفصل، وهو قوله: «لا تكرم العالم الفاسق» من إيكال أمر تشخيص ذلك إلى المكلّف نفسه، وبهذا اختلف العام عن مثال أمر المولى في خطاب خاصّ بإكرام هذا الفرد المشكوك. هذا مضافًا إلى أنّ الجمع بين إنشاء وجوب إكرام العالم الذي ليس بفاسق والإخبار بكون هذا الفرد المشكوك غير فاسق من الجمع بين الإنشاء والإخبار في كلام واحد، وهذا إن لم يكن مستحيلًا، فلا أقل من عدم صحته إثباتًا.
ثانيهما: أن يكون المولى في الخطاب العام بصدد بيان حكم ظاهريّ، وهو أنّ الأصل في العالم أن يكون عادلًا، مضافًا إلى بيان الحكم الواقعيّ، وهو وجوب إكرام كلّ عالم ليس بفاسق.
وفيه: أنّ استفادة هذا الحكم الظاهريّ من العام خلاف الوجدان، مضافًا إلى أنّ الوجوب الظاهريّ لإكرام الفرد المشكوك فرع ثبوت الوجوب الواقعيّ له على تقدير عدالته واقعًا؛ لأنّ الحكم الظاهريّ في طول احتمال ثبوت الحكم الواقعيّ. وحينئذٍ، إن أريد التمسك بالعام في الفرد المشكوك مرّتين، مرّة لإثبات وجوب إكرامه الواقعيّ مشروطاً بعدالته، ومرّة أخرى لإثبات وجوب إكرامه الظاهريّ، فهو واضح الفساد؛ فإنّ الدليل لا يتكفّل إلا إثبات وجوب إكرام واحد على كلّ فرد، وإن أريد التمسك به لإثبات الوجوب الظاهريّ فقط، فهو غير معقول؛ لأنّه كما أشرنا في طول ثبوت الوجوب الواقعيّ، ودعوى أنّ المدلول المطابقيّ إنّما هو الوجوب الظاهريّ، وليكن ثبوت الوجوب الواقعيّ المشروط مستكشفاً بالدلالة الالتزاميّة، مدفوعة بأنّ الوجوب الظاهريّ ليس في طول ثبوت الوجوب الواقعيّ في لوح الواقع، بل في طول احتماله، فلا يمكن أن يكون احتماله بنفس وصول الحكم الظاهريّ أو في طوله. وبذلك اتضح عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل.
وما أفاده في الإشكال على هذا التقريب، وإن كان تامًّا، لكن ما ذكره من استحالة تكفّل خطاب واحد للحكم الواقعيّ والظاهريّ معًا غير متجه؛ فإنّه لا يوجد مانع من ذلك عقلًا؛ لأنّ جعل الحكم الظاهريّ يكون في طول لحاظ موضوعه، وهو احتمال الحكم الواقعي، لا في طول وجود موضوعه خارجًا، فلا طوليّة بين الجعلين، بل لا يوجد مانع عرفيّ من الجمع بينهما في مثل «إذا علمت أنّ مائعًا خمر فلا تشربه»؛ حيث يستفاد منه عرفًا حرمة شرب الخمر واقعًا، والترخيص الظاهريّ في شربها في فرض الشك في كون مائع خمرًا، من غير أن يلزم من ذلك استعمال اللفظ في معنيّين؛ لاستفادة الحكم الظاهريّ من المدلول المطابقيّ والآخر من المدلول الالتزاميّ، كما لا يلزم محذور عرفيّ من لحاظ حكمين طوليّين؛ لأنّ موضوع الحكم الظاهريّ في الشبهة الموضوعيّة إثباتًا هو الشكّ في الموضوع التكوينيّ، وإن كان متضيّقًا عقلًا بفرض احتمال حكم واقعيّ.
فالمهمّ في الإشكال في استفادة حكم ظاهريّ في المقام من العام هو عدم تكفّل الخطاب العام كقوله: «أكرم كلّ عالم» إلا لبيان الحكم الواقعيّ، دون الظاهريّ؛ فإنّ وجوب الإكرام ظاهرًا إن كان موضوعه الشك في اندراج الفرد في العنوان المخصّص، فلا يستفاد من العام؛ لأنّه لم يفرض في العام وجود المخصّص، فضلًا عن كون فرد من العالم شبهة مصداقيّة للمخصّص، وإن كان موضوعه الشك في وجوب إكرامه واقعًا، فالمفروض أنّ الخطاب العام يبيِّن وجوب إكرام كلّ عالم واقعًا، فلا يبقى مجال عرفًا لبيان وجوب ظاهريّ في فرض الشك في وجوبه الواقعيّ؛ فإنّ ضمّ بيان الحكم الظاهريّ لوجوب إكرام كلّ عالم إلى بيان وجوبه الواقعيّ مطلقًا لغو عرفًا؛ على أنّ إرادة كليهما من المدلول المطابقيّ تكون من استعمال اللفظ في معنيّين، ولا ملازمة بين الوجوب الواقعيّ والظاهريّ، لا عرفًا ولا عقلًا حتى تنشأ من الخطاب دلالة التزاميّة على الوجوب الظاهريّ. وأمّا احتمال كون العام مبيِّنًا للوجوب الظاهريّ لإكرام كلّ فرد من العالم يشك في وجوب إكرامه واقعًا، فيدلّ بالالتزام على وجوب إكرامه واقعًا في الجملة، فساقط وجدانًا.
والحاصل أنّ الخطاب العام في القضيّة الحقيقيّة متكفّل لبيان الجعل من دون نظر إلى مرحلة المجعول الذي يترتب على وجود موضوعه في الخارج، فضلًا عن الشك في المجعول وجعل حكم ظاهريّ له، والمفروض أنّ المخصّص المنفصل خصّص الجعل العام بغير مورد التخصيص، فلا يجوز التمسك بالخطاب العام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل.
ثمّ إنّ ما ذكره في التقريب الثالث من نكتة الفرق بين العام والمطلق، سيأتي منّا الإشكال عليه.
ثمّ إنّه قد يستثنى من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل ثلاثة فروض:
الفرض الأول: ما ذكره صاحب الكفاية؟ق؟ من أنّه إذا كان المخصّص المنفصل لبّيًّا فالظاهر حجيّة العام في المصداق المشتبه منه؛ مثلًا إذا قال المولى: «أكرم جيراني» وقطع بأنّه لا يريد إكرام من كان عدوًّا له منهم كان أصالة العموم باقية على الحجيّة بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن العموم للعلم بعداوته؛ لعدم حجة أخرى غير العلم على خلاف ذلك العموم، بخلاف ما إذا كان المخصّص لفظيًّا؛ فإنّ قضيّة تقديمه عليه هو كون الملقى إليه كأنّه كان من رأس لا يعمّ الخاص، كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص متصلًا، والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجيّته إلا فيما قطع أنّه عدوّه، لا فيما شك فيه، كما يظهر ذلك من شهادة الوجدان بصحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم العبد بعض جيرانه لاحتمال عداوته له، بل يمكن أن يقال: إنّ قضيّة عمومه للمشكوك أنّ هذا المشكوك ليس فردًا من العنوان الذي علم بخروجه من حكم العام. مثال ذلك أنّه ورد: «ولعن اللّه بني أميّة قاطبة» ويعلم من الخارج عدم جواز لعن المؤمن، فإذا شك في إيمان فرد من بني أميّة، فيتمسك بهذا العموم لإثبات جواز لعنه، فينفى بذلك كونه مؤمنًا؛ نعم، إن كان المخصّص اللبّيّ متصلًا بأن كان ممّا يصح أن يتّكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب، فلا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوص. وممّن اختار هذا الوجه المحقق النائينيّ؟ق؟.
والصحيح تماميّة هذا البيان في خصوص ما إذا كان العام بنحو القضيّة الخارجيّة، كما في مثال أمر المولى عبده بإكرام جيرانه؛ فإنّ ظاهره أنّ المولى تصدّى بنفسه لتطبيق تمام غرضه، وهو إكرام الجار غير العدوّ على مصاديقه، فرأى أنّه لا يوجد في جيرانه عدوّ له، فأمر بإكرامهم من دون استثناء، فلو علم بكون واحد منهم عدوًّا للمولى، فيعلم بخروجه عن العام، لكن لا يكشف ذلك عن كون الخارج هو عنوان العدوّ، بل القدر المتيقّن هو تخصيص ذلك الفرد، فلو شك في كون فرد آخر عدوًّا للمولى، فيكون الشك في تخصيصه شكًّا في التخصيص الزائد. نعم، لو ورد في خطاب لفظيّ النهي عن إكرام العدوّ من جيرانه، فهذا يعني إيكال المولى تطبيق تمام غرضه إلى العبد نفسه، فلا يصح الرجوع إلى العامّ لإزالة الشك في كون واحد من الجيران عدوّ المولى، بعد أن لم يكن خروجه عن العام مستلزمًا للتخصيص الزائد.
ثمّ إنّه لا فرق في جواز التمسك بالعام في هذا الفرض بين كون المقيّد اللبّيّ متصلًا أو منفصلًا. فلو علمنا بقرينة واضحة من حال المولى أنّه لا يريد إكرام عدوّه أبدًا، ومع ذلك أطلق كلامه بإكرام جيرانه، فعند الشكّ في كون أحدهم عدوًّا له، فلا يجوز عند العقلاء ترك إكرامه؛ حيث إنّ ظاهر قوله: «أكرم جيراني» هو أنّ المولى بنفسه تصدّى لإحراز انطباق تمام غرضه على المصاديق، ووضوح عدم أمره بإكرام عدوّه، لا يعني عدم ظهور خطابه في هذا التصدّي.
وأمّا لو كانت القضيّة حقيقيّة، كما لو أمر المولى بإكرام كلّ عالم، وعلم بأنّه لا يأمر بإكرام العالم الناصبيّ، فحيث إنّه لا يمكن عادة تصدّي المولى لتطبيق تمام غرضه على مصاديقه، فيعلم أنّ المولى خصّص عنوان العالم الناصبيّ، وأوكل أمر التطبيق إلى المكلف نفسه، فلا يجوز التمسك بالعام في شبهته المصداقيّة.
ونكتة الفرق بين القضيّة الحقيقيّة والخارجيّة هي أنّه يمكن للمولى عادة التصدّي لتطبيق تمام غرضه على مصاديقه في القضيّة الخارجيّة، دون القضيّة الحقيقيّة التي تكون أفرادها غير محصورة عادةً. وهذا يوجب ظهور الخطاب الوارد على نهج القضيّة الخارجيّة في تصدّي المولى للتطبيق، دون الخطاب الوارد على نهج القضيّة الحقيقيّة؛ فلو فرض وجود هذه النكتة في خطاب مجعول على نهج القضايا الحقيقيّة، كان ملحقًا من هذه الجهة بالقضيّة الخارجيّة. مثال ذلك أنّه لو شك في طهارة نوع خاص من الماء، كالماء المتغيّر رائحته بمجاورة النجس، فيمكن التمسك بما دلّ على أنّ كلّ ماء مطهّر، مع أنّنا نعلم بأنّه لو كان نجسًا لَما كان مطهّرًا، لكن هذا العموم يكشف عن أنّ الشارع لاحظ أنواع المياه، ولم ير فيها ماءً نجسًا، ولذا حكم بأنّ كلّ ماء مطهّر؛ فلو علمنا بنجاسة ماءٍ، كالماء المتغيّر بملاقاة النجس، فلا دليل على أنّه خارج بعنوان كلّيّ النجس، بل بمقتضى كون المقيّد لبّيًّا نقتصر على المتيقّن منه، وهو الخروج بعنوانه الخاص، وفي الزائد عليه يكون الشك في التخصيص الزائد المنفيّ بأصالة العموم.
ومن هنا يتضح أنّه كلّما يوجد أمران: ظهور الخطاب في تصدّي المولى لتطبيق تمام غرضه على المصاديق، وكون المقيّد لبّيًّا، فعندئذٍ يمكن التمسك بالخطاب عند الشك في التطبيق، ففي القضايا الخارجية يتوفّر الأمران عادةً، لكن في القضايا الحقيقيّة لا يوجد الأمر الأول إلا في الشبهات الحكميّة. أمّا الشبهات الموضوعيّة، فلفرض أنّها في القضايا الحقيقيّة ليست محصورة عادةً فلا يمكن للمولى بما هو مولى لحاظها في مقام الجعل والتصدّي لتطبيق تمام الغرض عليها.
الفرض الثاني: ما ذكره في البحوث من أنّه لو كانت الشبهة المصداقيّة في نفسها شبهة حكميّة، كما لو ورد أنّ كلّ بيع صحيح، ثمّ ورد في خطاب منفصل أنّ البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة في زمان وجوبها باطل، وشككنا في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، فهو وإن كان شبهة مصداقيّة للمخصّص المنفصل، لكنّه بنفسه شبهة حكميّة يرجع فيه لرفع الشبهة إلى الشارع، فقد يقال بجواز التمسك حينئذٍ بالعام في الشبهات المصداقيّة للمخصّص جائز، فيحكم حينئذٍ بصحة البيع وقت النداء في عصر الغيبة.
وذكر في البحوث أنّه يمكن التمسك بالخطاب إذا كان عامًّا، دون ما كان مطلقًا؛ لعدم تعرّضه لبيان حكم الأفراد، بل الطبيعة فقط، فيحكم بصحة البيع وقت النداء في عصر الغيبة؛ لأنّه شبهة حكميّة يصلح أنّ يبيّن المولى حاله في خطابه، وحيث قال أوّلًا أنّ كلّ بيع صحيح، كشف عن صحة البيع في زمن الغيبة أيضًا، ولا حجّة على خلافه. ولذا يحكم بصحته. ومثّل له أيضًا بما إذا ورد أنّ كلّ ماء مطهّر، ثمّ ورد أنّ الماء النجس لا يطهِّر، لكن لا ندري هل ماء الاستنجاء نجس أم لا؟؛ فإنّ قيد الطهارة ممّا يمكن للشارع أن يضمن وجوده في تمام أفراد الماء المحقّقة والمقدّرة الوجود. وذلك كما إذا حكم في خطاب آخر أنّ كلّ ماء طاهر؛ وعليه، فيمكن التمسك بعموم قوله: «كلّ ماء مطهّر» لمّا شكّ في نجاسته بنحو الشبهة الحكميّة، وإن كان شبهة مصداقيّة للمخصّص المنفصل، أي قوله: «الماء النجس ليس مطهِّرًا».
وفيه: أنّ ظهور خطاب العام وإن كان في تصدّي المولى لتطبيق تمام غرضه على المصاديق في الشبهات الحكميّة، ولكنّ المخصّص اللفظيّ الوارد على نهج القضيّة الحقيقيّة، يشكل قرينة نوعيّة على أنّ المولى أوكل أمر التطبيق إلى المكلّفين؛ حيث إنّ العرف بعد استكشاف المراد الجدّيّ من العام يَراه حجّة فيما عدا مورد التخصيص، فقوله: «كلّ بيع صحيح» يكون بعد تخصيصه بما ورد من أنّ البيع وقت وجوب صلاة الجمعة باطل، حجّة في قضيّة حقيقيّة، وهو صحة البيع الذي لا يكون في وقت وجوب صلاة الجمعة، ويكون أمر تشخيص مصاديقه موكولًا إلى المكلّف نفسه.
ثمّ إنّا لم نفهم وجه الفرق بين العامّ والمطلق؛ فإنّ مجرد كون الحكم في الخطاب منصبًّا على الأفراد في العموم، وعلى الطبيعة في الإطلاق، لا يوجب اختلافًا في ذلك. ولذا لو كان المخصّص المنفصل لبّيًّا واحتمل اختصاصه بالبيع وقت النداء في عصر الحضور -مثلًا-،أمكن التمسك بالخطاب لتصحيح البيع المقارن لوقت النداء في زمن الغيبة، بلا فرق بين كون ذاك الخطاب عامًّا أو مطلقًا، على أنّه في الخطاب المطلق أيضًا قد ينصبّ الحكم على الأفراد، كالجمع المضاف، مثل قوله: «أكرم علماء البلد»، بل الجمع المحلّى باللام على ما هو المختار وفاقًا لـ الكفاية والبحوث من عدم كونه من أداة العموم.
ثمّ إنّه لا وجه لما حكي عنه من أنّه ذكر شرطًا ثانيًا للتمسك بالعام في هذا الحال، وهو أن لا نعلم بفقدان القيد في بعض أفراد العام؛ فإنّ المفروض عدم قرينة على أخذ القيد بنحو القضيّة الحقيقيّة في موضوع العام، بل لعلّ الفرد أو النوع الذي علم انتفاء القيد فيه أخرج بعنوانه الخاص. ولذا ذكر أنّه يصح التمسك بعموم «كلّ ماء مطهّر» بالنسبة إلى ما شك في نجاسته بنحو الشبهة الحكميّة مع العلم بنجاسة بعض المياه، كالماء القليل الملاقي للنجس، ولم نفهم وجه الدفاع في تعليقة البحوث عنه.
هذا، وقد ذكر في بحوث الفقه أنّه لا فرق في جواز التمسك في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل إذا كانت شبهة حكميّة في حدّ نفسها بين العامّ والمطلق.
وحكي في تعليقة الكتاب عنه في بحث الأصول أنّه مثّّل له بالماء الذي يشك في طهارته ونجاسته بنحو الشبهة الحكميّة، لا الموضوعية، وذكر في العامّ أنّ ظهوره في مطهِّريّة كلّ ماءٍ شاملٌ للفرد المشكوك، ودالّ بالالتزام على طهارته؛ لأنّ بيان الشبهة الحكميّة من وظيفة المولى نفسه، فهو بما هو مولى أعرف بحدودها وشؤونها، وليست نسبتها إليه كنسبتها إلينا. والمفروض أنّ خطاب المولى ظاهر بنفسه في شمول هذا الفرد المشكوك وإثبات حكم العام له؛ لأنّ العموم يثبت الحكم على كلّ فرد فرد بحيث يكون الشك في خروج فرد شكًّا في تخصيص زائد، فلا بأس بأن يتمسك بأصالة العموم وعدم التخصيص الزائد، ويكون دالًّا بالالتزام على تحقق الموضوع -وهو الطهارة- فيه، وأنّ ثبوت الحكم إنّما هو لكونه واجدًا للموضوع، بعد أن كان أمر هذا الموضوع بيد المولى نفسه. ولکن حيث إنّ هذا البيان لا يأتي في الخطاب المطلق، باعتبار أنّه ليس فيه دلالة على ثبوت الحكم لكلّ فردٍ فردٍ من أفراد الموضوع، كي يتمسك بهذا الظهور بالنسبة إلى الفرد المشكوك، وإنّما الحكم قد انصبّ فيه على الطبيعة ابتداءً، وانطباقها على الأفراد ليس إلا بحكم العقل، لا بدلالة اللفظ. والمفروض إحراز التقييد في المطلق وأنّ الحكم بالمطهِّريّة -مثلًا- مرتّب على الماء الطاهر، لا طبيعيّ الماء؛ فعند الشك في فرد من المياه هل هو طاهر أم نجس؟ لا يمكننا إثبات الحكم فيه، لا بدلالة اللفظ في المطلق؛ لأنّه لم يكن شاملًا للأفراد، ولا بدلالة العقل وتطبيق الطبيعة على أفرادها؛ لأنّنا أحرزنا أنّ الطبيعة المأخوذة في موضوع الحكم مقيّدة بالطاهر، وهو مشكوك الانطباق حسب الفرض.
فنحتاج إلى تقريب آخر يوصلنا إلى نفس النتيجة في المطلقات عند الشك بنحو الشبهة المصداقيّة بينها وبين مقيّداتها، وحاصل هذا التقريب هو أنّنا نحتمل أن يكون المولى قد أحرز تحقّق القيد في تمام أفراد الطبيعة، باعتبار أنّ القيد حكم شرعيّ في نفسه، والشبهة حكميّة بهذا الاعتبار، وبهذا الاعتبار قد جعل الحكم بالمطهِّريّة على طبيعيّ الماء، فيكون الإطلاق كاشفًا عن ثبوت الملاك في تمام موارد الطبيعة. ولكن هذا البيان لا يتمّ فيما إذا أحرزنا تحقّق مصداق للمقيّد خارجًا، كما لو أحرزنا نجاسة ماء البحر -مثلًا-؛ فإنّه حينئذٍ لا يمكننا إثبات الحكم في ماء آخر نشك في طهارته ونجاسته؛ لأنّنا علمنا في مثل ذلك أنّ الطبيعة المطلقة ليست مساوية مع الطبيعة المقيدة التي هي موضوع الحكم واقعًا.
وهذا بخلاف الحال في العامّ المخصّص؛ فإنّه حتى لو علمنا فيه بتحقّق مصداق للمخصّص خارجًا وأنّ الطبيعة المطلقة لا تساوي المقيدة، مع ذلك يصح التمسك بالعموم في الفرد المشكوك؛ لأنّه مشمول بنفسه لدلالة العام على ثبوت الحكم لكلّ فرد فرد، فيكون الشك فيه لا محالة شكًّا في تخصيص زائد بلحاظ هذا الظهور منفيًّا بأصالة العموم.
وأنت ترى ما في هذه الكلمات من اختلاف، مضافًا إلى ما مرّ من أنّه فرض أنّه كان هناك مخصّص أو مقيِّد لفظيّ يكون مفاده تخصيص العامّ أو تقييد المطلق، وإخراج فاقد القيد عنه بعنوان كلّيّ يحتمل انطباقه على المشكوك، فهذا يعني إيكال تشخيص المصداق إلى المكلف نفسه بالرجوع إلى سائر الخطابات أو الأصل العمليّ.
وإن لم يكن مخصّص أو مقيّد لفظيّ فالقدر المتيقّن إخراج الفرد المعلوم خروجه بعنوان نفسه؛ وعليه، فيكون الشك في إخراج الفرد المشكوك من الشك في التخصيص أو التقييد الزائد، فتجري أصالة العموم والإطلاق لنفيه.
الفرض الثالث: -من فروض الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل، ولو بنحو استفادة حكم طريقيّ من باب الأصل العمليّ- ما ذكره المحقق النائينيّ؟ق؟ من أنّه لو كان العام متضمّنًا لحكم إلزاميّ، والخاص متضمّنًا لحكم ترخيصيّ مترتب على عنوان وجوديّ، فالعرف يستفيد منه ثبوت الحكم الطريقيّ عند عدم إحرازه؛ ضرورةَ أنّ المولى إذا قال لعبده: «لا تأذن في دخول داري إلا لأصدقائي» أو: «قسِّم هذا المال في الفقراء»، فإنّه يفهم من هذا التعليق عدم جواز الإذن عند عدم إحراز الصداقة، وعدم جواز الإعطاء إلا عند إحراز الفقر، وعليه يبتني حرمة التصرف في أموال الغير عند الشك في طيب نفسه؛ لأنّ جواز التصرف عُلِّقَ على طيب النّفس، فلا يترتب إلا عند إحرازه، بل مطلق وجوب الاحتياط في الأموال والأنفس والأعراض مبتنٍ عليه؛ فإنّ جواز التصرف في كلّ منها مترتّب على العناوين الوجوديّة، فينتفي عند الشك فيها. وعلى ذلك بنينا أصالة الانفعال في الماء حتى يحرز كونه كرًّا؛ لترتب عدم الانفعال على عنوان وجوديّ، وهو بلوغ الماء كرًّا. وذكرنا في محلّه أنّ الحكم بالانفعال مع الشك في الكرّيّة ليس من جهة قاعدة المقتضي والمانع الغير الثابت حجيّتها، ولا من جهة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقيّة المختار عدم جوازه، بل لأجل ما ذكرناه من استفادة الحكم الطريقيّ من تعليق الحكم على عنوان وجوديّ.
وفيه: العرف لا يرى منعًا من التمسك بما صدر من هذا المولى من قوله: «رفع ما لا يعلمون» أو قوله: «كلّ شيء حلال» في مثل ما لو توارد حالة الصداقة وعدم الصداقة بالنسبة إلى من أريد إدخاله في الدار، مع الجهل بتأريخهما، بحيث لا يجري استصحاب عدم كون الداخل صديق المولى، إلا إذا كان البيت ملك المولى، بحيث يحتاج التصرف فيه في بناء العقلاء إلى إحراز الإذن. ولا وجه لدعوى استظهار العرف من الخطاب كون الحكم الإلزاميّ ثابتًا للفرد المشكوك واقعًا بأن يكون المستثنى من العام هو ما علم كونه معنونًا بعنوان الخاص أو دعوى انعقاد مدلول التزاميّ عرفيّ في لزوم الاحتياط في مورد الشك.
إجراء الأصل لإلحاق الشبهة المصداقيّة بالعام
وقد يلحق الشبهة المصداقيّة للمخصّص المتصل أو المنفصل بالعام تارة بإجراء قاعدة المقتضي والمانع، وأخرى بإجراء الاستصحاب؛ أمّا قاعدة المقتضي والمانع، فقد مرّ نقلها عن صاحب العروة؟ق؟، فيدّعى بأنّ هناك قاعدة عقلائيّة، وهي أنّه إذا ثبت المقتضي -بالكسر- لشيء، ولم يثبت المانع عنه، فيبني العقلاء على تحقق المقتضى -بالفتح- وهذا يختص بما يستظهر العرف كون عنوان الخاص مانعًا عن ثبوت حكم العام لعنوانه، كما لو قال: «أكرم كلّ عالم ولا تكرم العالم الفاسق»، لا كونه شرطًا له، كما لو قال: «أكرم كلّ عالم، وليكن عادلًا».
والصحيح عدم ثبوت بناء عقلائيّ من هذا القبيل؛ فلو رمى سهمًا إلى جانب زيد واحتمل وجود حائل يمنع عن وصول السهم إليه وقتله به، فمن الواضح أنّ العقلاء لا يرتّبون آثار القتل، ولا وجه لدعوى قيام بنائهم عليه في خصوص ما إذا كان الأثر مترتّبًا على موضوع مركّب من وجود شيء يكون مقتضيًا له وعدم شيء آخر يكون مانعًا عنه؛ نعم، ذكر بعض الأجلّاء؟دظ؟ أنّه إذا كان المانع من العناوين الثانويّة، فبناء العقلاء على ترتيب آثار العنوان الأوليّ ما لم يثبت وجود المانع، وذلك مثل الضرر أو الحرج، وهذا غير بعيد.
وأمّا التمسك بالاستصحاب لنفي كون الفرد المشكوك من أفراد المخصّص، فلا إشكال فيه إذا كان له حالة سابقة متيقّنة بنحو السالبة بانتفاء المحمول، وإنّما الإشكال فيما إذا كانت الحالة السابقة المتيقّنة له بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، كما ورد في الحديث: «كلّ امرأة تحيض إلى خمسين سنة إلا أن تكون امرأة من قريش»؛ فإنّه إذا شك في كون امرأة قرشيّة، فلا حالة سابقة متيقّنة لها؛ لأنّها من بدء وجودها إمّا قرشيّة أو ليست بقرشيّة، فإن أريد استصحاب عدم قرشيّتها، فلا بدّ أن تكون القضيّة المتيقّنة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، فيقال إنّ هذه المرأة لم تكن قرشيّة قبل وجودها، فيستصحب عدم كونها قرشيّة حتى بعد وجودها، فينفى بذلك حكم القرشيّة عنها ويثبت لها حكم المرأة التي ليست قرشيّة، وهذا هو المعروف بـ«استصحاب العدم الأزليّ»، فينبغي الكلام حوله.
استصحاب العدم الأزليّ
فقد ذهب صاحب الكفاية؟ق؟ إلى جريانه، ووافقه في ذلك جماعة منهم السيد الخوئيّ؟ق؟ وخالف في ذلك المحقق النائينيّ؟ق؟. واستدلّ على ذلك بـعدّة مقدّمات:
المقدّمة الأولى: أنّ التخصيص إنّما يوجب تقييد موضوع العام بغير عنوان المخصّص، فإذا كان المخصّص أمراً وجوديًّا كان الباقي تحت العام معنونًا بنقيضه؛ فإنّه إذا جعل المولى وجوب الإكرام للعالم، ثمّ ورد مخصّص يدلّ على عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، فلا بدّ أن يجعل وجوب الإكرام للعالم المقيّد بعدم كونه فاسقًا؛ لأنّ إطلاقه لفرض كونه فاسقًا غير معقول؛ لاستلزامه التهافت والتناقض بينه وبين الدليل الخاص، كما أنّ إهماله غير معقول؛ لأنّه لا يعقل جهل الحاكم بموضوع حكمه، فيتعيّن التقييد.
المقدّمة الثانية: أنّ العرض تارةً يلحظ وجوده وعدمه في نفسه، فيقال -مثلًا-: «إنّ البياض موجود أو إنّه معدوم»، ويسمّى هذا الوجود والعدم بـ«الوجود والعدم المحموليّین»، وأخرى يلحظ وجود العرض أو عدمه بما هو نعت لمعروضه، فيقال: «هذا الجسم أبيض أو إنّه ليس بأبيض»، ويعبّر عن ذلك بـ«الوجود والعدم النعتيّين» تارة؛ حيث إنّهما بنحو مفاد «كان» و«ليس» الناقصتين.
وهذا الوجود والعدم يحتاجان في تحققهما إلى وجود الموضوع في الخارج، فلو انعدم الجسم فلا يصدق أنّه أبيض، كما لا يصدق أنّه ليس بأبيض، وهذا ليس من ارتفاع النقيضين، بل يكون تقابلهما بنحو تقابل العدم والملكة؛ فإنّ الفرد الخارجيّ من الجسم إمّا أبيض أو ليس بأبيض. وأمّا المعدوم، فلا يعقل اتصافه بشيء منهما. وهذا بخلاف الوجود والعدم المحموليّين؛ فإنّ تقابلهما يكون بنحو تقابل السلب والإيجاب، فلا يمكن ارتفاعهما معًا؛ فإنّه من ارتفاع النقيضين.
وهناك ثلاثة احتمالات في تفسير كلامه:
الاحتمال الأول: ما فهمه السيد الخوئيّ؟ق؟ وتلامذته من كلماته من أنّ العدم المحموليّ هو سلب اتصاف الموضوع بالمحمول، كسلب اتصاف الحجر بكونه أبيض مثلًا، والمراد من العدم النعتيّ اتصافه بسلبه عنه، كاتصاف الحجر بعدم كونه أبيض. ثمّ أشكلوا عليه بما سيأتي من أنّ السالبة المحصّلة لا تعني إلا سلب الاتصاف، لا الاتصاف بالسلب؛ ولكن لا يساعد الكلمات المنقولة عنه على هذا الاحتمال، وقد نقل الشيخ حسين الحليّ؟ق؟ عنه أنّه قال: إنّ العدم النعتيّ هو عدم المحمول لموضوعه، في قبال الوجود النعتيّ الذي هو وجود المحمول لموضوعه، فلا يصح قبل وجود المرأة أن يقال إنّها لم تكن قرشيّة. ثمّ ذكر أنّ الغرض من نقل هذا المطلب هو الإشارة إلى خطأ محشّي أجود التقريرات -يعني السيد الخوئيّ؟ق؟- من كون المراد من العدم النعتيّ هو اتصاف الموضوع بسلب المحمول عنه؛ فإنّه من الموجبة المعدولة المحمول، مع أنّ شيخنا؟ق؟ لم يقُل به، وإنّما قال: السالبة المحصّلة مفادها سلب الاتصاف بالمحمول، ولكن هذا المفاد ممّا لا يمكن تحققه قبل وجود الموضوع.
وما في حاشية أجود التقريرات من أنّ عدم العرض لا يحتاج إلى وجود الموضوع، فعدم البياض لا يحتاج إلى الجدار، ففيه: أنّ العدم المحموليّ، أي عدم البياض، لا يحتاج إلى الجدار؛ ولكنّ العدم النعتيّ، أي عدم البياض لهذا الجدار، يحتاج إلى وجود الجدار.
ومن طريف ما أفاده -أي المحقق النائينيّ؟ق؟- في ذلك أنّ لازم صدق السالبة البسيطة أن يصدق قولنا: «إنّ زيدًا قبل وجوده ليس بساكن» وحينئذٍ يلزم أن يكون متحرّكًا؛ لأنّهما ضدّان لا ثالث لهما، فلا يرتفعان. فإذا صحّ نفي أحدهما كان لازمه ثبوت الآخر. وحينئذٍ يكون زيد قبل وجوده ليس بساكن، فهو متحرك، كما أنّه ليس بمتحرّك فهو ساكن، ولا يخفى ما فيه من اجتماع الضدّين والنقيضين.
وسيأتي صدق السالبة مع انتفاء الموضوع، وأما مثال الضدين ليس لهما ثالث فجوابه أنه لا يوجد أي مانع من أن يقال: «هذا الجسم قبل وجوده لم يكن ساكنا ولا متحركا؛ لأنه لم يكن موجودا بعدُ»؛ نعم، حينما تكتفي بأن تقول إنّه لم يكن ساكنا قبل وجوده، فيكون مدلوله العرفي أنّه كان متحركا، وهذا يوجب الإشكال.
الاحتمال الثاني: أن يكون المراد من العدم النعتيّ سلب العرضيّ عن الموضوع، وهو الذي يعبّر عنه بـ«مفاد ليس الناقصة»، كقولنا: «لم يكن هذا الحجر أبيض»؛ فإنّ ما يوجب تقسيم الجسم إلى قسمين، هو لحاظ العرض نعتًا له بحمل العرضيّ المشتق من ذلك العرض -أي الأبيض- عليه أو سلبه عنه.
ويكون المراد من العدم المحموليّ، كقولنا: «لم يكن البياض لهذا الجسم موجودًا» بحيث لو كان موضوع الحكم مركّبًا من العدم المحموليّ ومن وجود الموضوع لوحِظا كأنّهما جوهران، من دون أن يلحظ كون عدم بياض الجسم مقسِّمًا للجسم إلى ما يقابل الجسم الأبيض، وحينئذٍ يقال إنّ استصحاب عدم البياض لهذا الجسم لا يثبت أنّه ليس بأبيض إلا بنحو الأصل المثبت.
الاحتمال الثالث: أن يكون المراد من العدم النعتيّ أن يلحظ العرض الذي يراد نفيه محصَّصًا ومضيَّقًا بهذا الموضوع، كعدم البياض لهذا الجسم أو عدم كونه أبيض، فلا فرق بين مفاد «لم يكن الحجر أبيض» أو بنحو مفاد «عدم البياض للحجر»، ويكون المراد من العدم المحموليّ عدم طبيعيّ البياض، ولو لوحظ اقتران هذا العدم مع وجود الموضوع، كأن يقال: «إذا وجد الحجر ولم يوجد بياض معه».
وهذا الاحتمال الثالث، وإن كان بعيدًا في حدّ ذاته، بل لا نتعقّل له معنًى واضحًا، لأنّ لازمه أنّه لو وجد حجر، ولم يكن أبيض، ولكن وجد بياض لجسم آخر مقترنًا معه، فلا ينطبق عليه الموضوع؛ لكن يوجد بعض الشواهد على هذا الاحتمال، وهو أنّه حكي في فوائد الأصول عن المحقق النائينيّ؟ق؟ أنّه قال: «إثبات العدم النعتيّ باستصحاب العدم الأزليّ يكون من أوضح أنحاء الأصل المثبت؛ إذ عدم وجود القرشيّة في الدنيا يلازم عقلًا عدم قرشيّة هذه المرأة المشكوك حالها.».
ثمّ إنّه قد ذكر المحقق النائينيّ؟ق؟ في رسالة الصلاة في اللباس المشكوك في تقريب العدم النعتيّ أنّ النعتيّة لم تؤخذ في ماهيّة البياض؛ فإنّها توجد في الذهن بوجود مستقل، وإنّما وجودها الخارجيّ رابطيّ، وحيث إنّ العدم يضاف إلى الماهيّة، لا إلى الوجود؛ إذ ما ينعدم إنّما هو الماهيّة، لا الوجود، فلا بدّ في العدم النعتيّ أن يكون نفس العدم نعتًا، وكلّ نعت محتاج إلى وجود محلّه، فلا يصدق قبل تحقّق محلّه؛ فالنافي للوجود النعتيّ للعرض هو العدم النعتيّ للعرض، وهو محتاج إلى وجود المحلّ أيضًا، كالوجود النعتيّ، فلا يفيد استصحاب العدم الأزليّ، لا لغرض إثبات حكم العام، ولا لنفي حكم الخاص، كنفي حرمة الإكرام الثابت للأمويّ في قوله: «يحرم إكرام الأمويّ» عن مشكوك الأمويّة.
وفيه: أنّه لا مانع من انتزاعيّة نعتيّة ماهيّة العرض من إضافتها إلى محلّها، فيقال: «بياض هذا الجدار» فيمكن أن يقال حينئذٍ: «بياض هذا الجدار لم يكن موجودًا»، بل لا مانع من إضافة العدم إلى مفهوم الوجود، ولا علاقة له بعدم عروض العدم في عالم التكوين للوجود، وإنّما هو بديل له.
والظاهر أنّ ما ذكره المحقق النائينيّ؟ق؟ هنا نفس بيانه العام لإنكار استصحاب العدم الأزلیّ، فما في البحوث من أنّ له بيانين:
أحدهما: أنّ قيد العام بعد تخصيصه هو الاتصاف بعدم العنوان الخاص، لا سلب الاتصاف.
وثانيهما: ما ذكره في رسالة الصلاة في المشكوك من أنّ النافي للوجود النعتيّ هو العدم النعتيّ، وهو محتاج إلى وجود المحلّ، وهذا يفيد حتى في مجال عدم جريان استصحاب العدم الأزليّ لنفي حكم الخاص.
المقدمة الثالثة: أنّ الموضوع إذا كان مركّبًا من جوهر وعرضه أو مركّبًا من جوهر وعدم عرضه، فلا محالة يكون المأخوذ في الموضوع هو العرض بوجوده أو عدمه النعتيّين، بل لو كان ظاهر الخطاب هو أخذ العدم المحموليّ، أي عدم العرض في موضوع الحكم كقوله: «إذا وجد حجر ولم يوجد معه بياض»، فلا بدّ من صرفه عن ظاهره وحمله على أخذ العدم النعتيّ؛ لأنّ إطلاق الجزء الأول، وهو الحجر لفرض كونه أبيض موجب لتهافته مع الجزء الثاني، فالإطلاق غير معقول، كما أنّ الإهمال من الحاكم الملتفت غير معقول، فيتعيّن تقييده بعدم كونه أبيض، ومعه فيلغو تقييده بعدم وجود البياض معه؛ لأنّ رتبة انقسام الشيء إلى حالاته ونعوته -كعدم كون الحجر أبيض- أسبق من رتبة تقييده بلحاظ مقارناته التي منها عدم وجود البياض معه. فعندئذٍ، إن كان لاتصاف الموضوع بوجوده أو بعدمه حالة سابقة، جرى استصحاب بقائه، وإلا فلا؛ نعم، لو كان الموضوع مركّبًا من جوهرين، كوجود زيد وعمرو، أو عرضين، ككون زيد عالمًا وعادلًا، أو جوهر وعرض لجوهر آخر، كوجود زيد وعدالة عمرو، فليس أحد جزئي الموضوع نعتًا للجزء الآخر، ولذا لا يلزم في استصحاب أحد الجزئين إلا العلم بحالته السابقة في حدّ ذاته، لا حالته السابقة حين وجود الآخر. فلو علم بكون زيد عادلًا قبل أن يصير عالمًا، فلا مانع من ضمّ العلم بكونه عالمًا فعلًا إلى استصحاب كونه عادلًا، وإن لم يعلم اتصافه بما هو عالم بالعدالة ولو سابقًا.
وبهذه المقدمات أثبت عدم جريان استصحاب العدم الأزليّ لغرض إلحاق الفرد المشكوك بموضوع حكم العام.
فتبيّن أنّ هذه المقدمات، وإن سيقت لغرض المنع من إجراء استصحاب العدم الأزليّ لتنقيح موضوع العام، ولكنّ الثابت من مبنى المحقق النائينيّ؟ق؟ هو المنع عن جريان استصحاب العدم الأزليّ حتى لنفي حكم الخاص أو الحكم المترتب على عنوان مشكوك الانطباق على فرد من بدء وجوده؛ فعليه، لو قال المولى: «لا تكرم الأمويّ»، فكون الفرد المشكوك أمويًّا أو عدم كونه أمويًّا ممّا لا حالة سابقة له قبل وجوده، وما له حالة سابقة هو عدم الأمويّة، واستصحابه لا يجدي لإثبات عدم كونه أمويًّا كي ينقّح به موضوع حرمة الإكرام. وهذا ما يظهر من المقدمة الثانية والثالثة اللّتين نقلناهما عن المحقق النائينيّ؟ق؟؛ نعم، المقدمة الأولى تختص بفرض تنقيح موضوع العام باستصحاب عدم كون الفرد المشكوك من أفراد العنوان الخاص.
وكيف كان، فيرد على المقدمة الأولى أنّها بصالح جريان استصحاب العدم الأزليّ، دون العكس. ولأجل ذلك، فحيث إنّ المحقق العراقيّ؟ق؟ لا يقبل هذه المقدمة في العام، فقد ذهب إلى أنّ استصحاب العدم الأزليّ وإن كان جاريًا في حدّ ذاته، لكن أثره نفي كون الفرد المشكوك من أفراد الخاص، فينفي بذلك حكم الخاص، كحرمة إكرام العالم الأمويّ، ولا يفيد بلحاظ إثبات حكم العام، كوجوب إكرام كلّ عالم. وبذلك يفترق العام عن المطلق، ففرق بين قوله: «أكرم العالم» مع فرض ورود: «لا تكرم العالم الأمويّ» وبين قوله: «أكرم كلّ عالم» مع فرض ورود هذا القول؛ فإنّه بجريان استصحاب العدم الأزليّ يجوز التمسك بالخطاب المطلق لإثبات وجوب إكرام العالم المشكوك كونه أمويًّا، ولا يجوز في العام.
والوجه في ذلك هو ما مرّ من الفرق بنظره بين التخصيص والتقييد؛ فإنّ التخصيص ليس موجبًا لتعنون موضوع العام بنقيض موضوع الخاص؛ فإنّ التخصيص بمنزلة موت بعض أفراد العام، فكما أنّه لو مات الشيوخ من العلماء، فهذا لا يعني تعنون قوله: «أكرم العلماء» بالشباب منهم، فكذلك التخصيص؛ فإنّه موت تشريعيّ لمورد التخصيص، أي نفي لحكم العام عنهم من دون تعنون العام بعنوان مخالف لمورد التخصيص. وأمّا التقييد، فهو موجب لتعنون موضوع المطلق. وحينئذٍ، فاستصحاب عدم كون الفرد المشكوك من أفراد الخاص لا يكون منقّحًا لحكم العام؛ لعدم كونه أصلًا موضوعيًّا بالنسبة إليه، فيكون إثبات حكم العام بالاستصحاب الموضوعيّ النافي لحكم الخاص من الأصل المثبت.
وإن كان ما ذكره المحقق العراقيّ؟ق؟ غير متجه، فإنّ الجمع بين إطلاق موضوع العام وإطلاق حكمه، وبين الدليل الخاص يكون مستلزمًا للتناقض والتهافت، فلا بدّ إمّا من تقييد موضوع العام، بأن يكون الواجب -مثلًا- إكرام كلّ عالم ليس بفاسق، أو تقييد الوجوب، بأن يجب إكرام كلّ عالم إذا لم يكن فاسقًا، وإلا، فكيف يتضيّق الحكم المجعول في العام، فلا يشمل مورد التخصيص، من دون لحاظ تقيّد موضوعه أو تقيّد نفس الحكم؟! وسواء تقيّد نفس الحكم أو موضوعه، فيكون استصحاب عدم كون الفرد المشكوك فاسقًا أصلًا موضوعيًّا لإثبات وجوب إكرامه.
هذا، ومن جهة أخرى إنّ هذا الإشكال -لو تمّ- فلا يختص باستصحاب العدم الأزليّ، بل يجري حتى في غيره، كما صرّح به نفسه، كمثال تخصيص العالم الفاسق عن وجوب إكرام كلّ عالم، فلا يفيد استصحاب عدم كونه فاسقًا لإثبات وجوب إكرامه؛ نعم، لو كان لنفس وجوب إكرامه حالة سابقة أمكن استصحابه.
وذكر نظيره السيد الحكيم؟ق؟، ولكنّه ذكر أنّ الإشكال مختصّ بما كان مضمون الخاص إثبات الحكم، لا نفيه، كما لو ورد: «لا يجب إكرام الفاسق»؛ فإنّ استصحاب عدم كون زيد فاسقًا، ينفي عدم وجوب إكرامه، ونفي النفي مساوق للإثبات.
وفيه: أنّ استصحاب عدم كونه فاسقًا إنّما يدلّ على انتفاء حصّة من عدم وجوب الإكرام، وهو عدم وجوب الإكرام الثابت للفاسق، وهذا لا يكون مساوقًا لإثبات وجوب الإكرام؛ إذ لا بدّ من ضمّ العلم بانتفاء سائر أفراد عدم وجوب الإكرام إليه، كعدم وجوب إكرام النحويّ والشاعر، ونحو ذلك، وهذا يعني كونه من الأصل المثبت.
وأمّا قياس التخصيص بموت بعض أفراد العامّ، فقد مرّ أنّه قياس مع الفارق؛ فإنّ موت بعض الأفراد موجب لارتفاع الحكم الفعليّ الذي هو معلول وجود الموضوع خارجًا، وارتفاعه لا يؤثّر في الجعل الذي هو مرتبط بمراد المولى، بخلاف التخصيص؛ فإنّه يتنافى مع بقاء موضوع الجعل في العام على عمومه، فيكشف المخصّص عن تقيّد موضوع العام ثبوتًا. وحينئذٍ، فيكون انطباقه على الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل مشكوكًا، فلا يمكن التمسك فيه بالعام.
هذا، وقد وافق بعض الأعلام؟ق؟ مع ما ذكره المحقق العراقيّ؟ق؟ ببيان آخر، فقال: «إنّه بناءً على عدم احتياج أداة العموم إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخولها، بل هو مدلول الأداة نفسها، فيكون مفاد العموم إرادة جميع أفراد الطبيعة المهملة، فلا يكون التخصيص مستلزمًا للتقييد؛ لأنّه لم يلحظ في مقام تعلّق الحكم، الطبيعة القابلة للإطلاق والتقييد، بل لوحظ جميع أفراد الطبيعة المهملة. ولا معنى للإطلاق والتقييد فيها؛ لأنّ الإطلاق والتقييد شأن الطبيعة، دون جميع الأفراد؛ وعليه، فالتخصيص لا يلازم تعنون العام بغير عنوان الخاصّ، بل غاية ما يتكفّله الدليل المخصّص هو إخراج بعض الأفراد الموجب لقصر حكم العام على البعض الآخر من دون تغيّر في موضوع الحكم، فيكون لدينا حصّتان: إحداهما محكومة بحكم العام، والأخرى محكومة بحكم الخاص. والفرد المشكوك يدور أمره واقعًا بين أن يكون من أفراد الحصّة المحكومة بحكم العام، وأن يكون من أفراد الحصّة المحكومة بحكم الخاص.
ومن الواضح أنّ استصحاب العدم الأزليّ لا يعيِّن كون الفرد من الحصّة المحكومة بحكم العام، إلا على القول بالأصل المثبت، بل بناءً على القول باحتياج مدخول أداة العموم إلى جريان مقدمات الحكمة فيه -كما التزم به المحقق النائينيّ؟ق؟ وقرّبناه- فالتخصيص وإن كان مستلزمًا للتقييد الأحواليّ، لكنّه لا يستلزم التقييد الأفراديّ؛ فإنّ العنوان المأخوذ في دليل الخاص إذا كان من أحوال الفرد، كعنوان الفاسق، فلا محالة يتقيّد موضوع الحكم؛ فإنّه مع إخراج بعض حالات الفرد عن الحكم يمتنع ملاحظة الطبيعة بنحو الإطلاق، بل لا بدّ من ملاحظتها مقيّدة بغير تلك الحال.
وبتعبير آخر: إنّ الفرد بما أنّ له حالتين، فلا يمكن التفريق بينهما إلا بتقييده بغير عنوان الخاص، فيكون موضوع الحكم هو العالم غير الفاسق؛ لعدم وجود الفرق ذاتًا بين ما هو محكوم بحكم العام وما هو محكوم بحكم الخاصّ إلا بلحاظ اختلاف الحالين، وهو يلازم التقييد.
وأمّا إذا كان التخصيص بلحاظ الخصوصيّات الذاتيّة للفرد -كما هو المفروض في استصحاب العدم الأزلي؛ لأنّ مورده الأوصاف اللازمة للذات من حين وجودها-، فلا يستلزم التخصيص تقيّد موضوع العام، بل يكون حكم العام واردًا على جملة من الأفراد، وحكم الخاص واردًا على جملة أخرى من الأفراد، فلا يتكفّل التخصيص سوى إخراج بعض الحصص، فيبقى حكم العام ثابتًا للحصص الأخرى بعنوانه من دون تقيّد بخصوصيّة أخرى؛ إذ لا معنى للتقييد في موضوع الحكم بلحاظ الأفراد الأخرى؛ فالأساس في منع جريان استصحاب العدم الأزليّ لإثبات حكم العام هو منع المقدمة الأولى.؛ ولكن اتضح ممّا ذكرناه فساد هذا الوجه؛ إذ كيف يمكن بقاء موضوع حكم العام وكذا نفس الحكم في الإرادة الجدّيّة للمولى على إطلاقه مع وجود المخصّص المنفصل الكاشف عن عدم الحكم الجدّيّ في مورد التخصيص؟! فإنّه لا يمكن إخراج مورد التخصيص عن العام المتكفّل للقضيّة الحقيقيّة إلا بلحاظ تقييد حكم العام أو موضوعه بعنوان لا ينطبق على مورد التخصيص حتى يتضيّق العام جدًّا، فلا يشمل مورد التخصيص.
هذا، وقد استدل المحقق الإصفهانيّ؟ق؟ على امتناع تعنون موضوع حكم العام بغير مورد التخصيص، باستدلال يشمل الخطاب المطلق الذي ورد عليه مقيّد منفصل على خلاف استدلال المحقق العراقيّ؟ق؟؛ حيث كان كلامه مختصًّا بالعام، دون المطلق. وهو أنّ ما يكون موضوعًا للحكم في البعث الإنشائيّ يكون هو الموضوع للبعث الحقيقيّ؛ لأنّ الإنشاء إنّما يكون بداعي جعل الداعي، ويستحيل الإنشاء بداعي جعل الداعي إلى غير ما تعلّق به، فإنشاء الحكم المتعلق بالصلاة يستحيل أن يكون داعيًا للصوم، كما أنّ إنشاء الحكم المتعلق بإكرام العالم يستحيل أن يكون داعيًا لإكرام غيره؛ وعليه، فبما أنّ الحكم المنشأ بالدليل العام أنشئ على الموضوع العام، فيستحيل أن يتقيّد بورود المخصّص؛ لاستلزامه اختلاف موضوع البعث الإنشائيّ عن موضوع البعث الحقيقيّ، وقد عرفت أنّه ممتنع.
وفيه:
أوّلًا: أنّ برهانه مختص بالخطابات التكليفيّة التي ورد عليها مخصّص منفصل، ولا يشمل الأحكام الوضعيّة، كما في مطهِّريّة الغسلة الواحدة للثوب الملاقي للنجس؛ حيث خصّص بما إذا كان ذلك النجس بولًا؛ فإنّه لا يأتي فيها نكتة البعث، كما لا يشمل فرض المخصّص المتصل.
وثانيًا: أنّ إنشاء البعث في العام الذي ورد عليه المخصّص المنفصل، وإن كان شاملًا لمورد التخصيص أيضًا، لكن خطاب المخصّص المنفصل يكشف عن اختصاص كونه بداعي البعث الجدّيّ -أو فقل كونه ناشئًا عن الإرادة المولويّة- بغير مورد التخصيص، وإلا لزم التهافت، وأين هذا من تباين متعلق البعث الإنشائيّ مع متعلق البعث الجدّيّ؟!
أمّا المقدمة الثانية، فیرد علیها: أنّ مفاد «ليس» الناقصة، كقولنا: «هذا الجدار لم يكن أبيض»، وإن كان ظاهرًا عرفًا في السالبة بانتفاء المحمول، لكنّه لا يعني كون استعمالها في السالبة بانتفاء الموضوع غلطًا، خاصةً إذا كان مع القرينة، فيقال: «هذا الجدار قبل وجوده لم يكن أبيض ولا أسود»؛ فإنّ ما يحتاج إلى وجود الموضوع هو الاتصاف بالعرض، وأمّا عدم الاتصاف بالعرض، فلا يحتاج إلى وجود الموضوع؛ نعم، لو كان الملحوظ في القضيّة هو الاتصاف بعدم العرض، كما في قولنا: «الجدار غير أبيض» أو: «إنّه لا أبيض» أو: «إنّه هو الذي ليس بأبيض»، فمن الواضح احتياجه إلى الموضوع؛ لكنّ الظاهر من السالبة المحصّلة، كقولنا: «ليس الجدار بأبيض» هو سلب الاتصاف، لا الاتصاف بالسلب. وهكذا بالنسبة إلى عدم العرض للموضوع، فيقال بأنّه لم يكن البياض لهذا الجدار موجودًا قبل وجود الجدار؛ وعليه، فما ذکره المحقق النائينيّ؟ق؟ في مثال الشك في قرشيّة امرأة من عدم صحة سلب اتصافها بالقرشيّة قبل وجودها، فلا يصدق أنّها لم تكن قرشيّة، ليس له وجه، فكيف بما حكاه عنه الشيخ حسين الحلّيّ؟ق؟ من عدم صحة أن يقال: «لم تكن القرشيّة لها قبل وجودها»؟!
وهكذا ما حکي عن السيد البروجرديّ؟ق؟ من أنّه لو قال شخص: «النار لم تكن محرقة قبل وجودها» فهو كذب عرفًا، والهذيّة إنّما تصدق عند وجود المشار إليه، ولا هذيّة للمرأة المعدومة، فلا عرفيّة لاستصحاب عدم قرشيّة هذه المرأة قبل وجودها، ولا أنّ هذه المرأة لم تكن قرشيّة قبل وجودها، وتكون أدلّة الاستصحاب منصرفة عنه.
وهكذا ما في تهذيب الأصول من أنّ القول بأنّ هذه المرأة لم تكن قرشيّة قبل وجودها قول كاذب؛ إذ لا ماهيّة قبل الوجود، والمعدوم المطلق لا يمكن الإشارة إليه، لا حسًّا ولا عقلًا، فلا تكون هذه المرأة قبل وجودها هذه المرأة، بل تلك الإشارة من مخترعات الخيال وأكاذيبها، فلا تتّحد القضيّة المتيقّنة مع القضيّة المشكوك فيها. وصحة الاستصحاب منوطة بوحدتهما. فالمرأة المشار إليها في حال وجودها ليست موضوعة للقضيّة المتيقّنة الحاكية عن ظرف العدم؛ لما عرفت أنّ القضايا السالبة لا تحكي عن النسبة والوجود الرابط، فلا تكون للنسبة السلبيّة واقعيّة حتى تكون القضيّة حاكية عنها، فانتساب هذه المرأة إلى قريش مسلوب أزلًا، بمعنى مسلوبيّة كلّ واحد من أجزاء القضيّة، أعني «هذه المرأة» و«قريش» و«الانتساب»، لا بمعنى مسلوبيّة الانتساب عن هذه المرأة إلى قريش؛ فإنّه بعد وجود هذه المرأة يمكن الإشارة إليها. ولذا لم يكن أيّ إشكال في صحة الإخبار عن عدم وجود هذه المرأة سابقًا بنحو مفاد «ليس» التامة. والتي تدلّ على سلب الوجود عن ماهيّة، فيمكن الإخبار أيضًا بأنّها لم تكن قرشيّة قبل وجودها، أو الإخبار بعدم وجود القرشيّة لها قبل وجودها. وكذا يصحّ الإخبار بأنّ هذا الجدار قبل وجوده لم يكن أبيض، كما لم يكن ذا لون آخر، وأنّ بياض هذا الجدار لم يكن موجودًا؛ نعم، لو كان الملحوظ في القضيّة هو الاتصاف بعدم العرض، كما في قولنا: «الجدار غير أبيض» أو: «إنّه لا أبيض» أو: «إنّه هو الذي ليس بأبيض»، فمن الواضح احتياجه إلى الموضوع.
أمّا المقدمة الثالثة -وهي لزوم أخذ العدم النعتيّ في موضوع الحكم-، فقد أورد عليها السيّد الخوئيّ؟ق؟ -حسب ما فهم من كلامه من كون العدم النعتيّ الاتصاف بالسلب- أنّه حيث لا يتحقق ربط بين عدم العرض والموضوع، فلا يؤخذ نعتًا إلا بنحو من العناية، فتكون القضيّة السالبة من المعدولة المحمول، كما في قولنا: «زيد أعمى»؛ ضرورة أنّ النسبة إنّما تكون بين وجودين، كالجوهر والعرض، ولا تكاد تكون بين وجود وعدم؛ إذ العدم لا يحتاج إلى الربط، فمن ثَمّ كان محموليًّا بحسب طبعه إلا أن يدلّ دليله على لحاظه على سبيل الناعتيّة بنحو من العناية حسبما عرفت.
وما اشتهر وتداول على الألسن من أنّ النسبة سلبيّة تارة وإيجابيّة أخرى، فليس المراد من السلبيّة ربط السلب، بل سلب الربط؛ فإنّ الموضوع والمحمول لمّا كانت بينهما نسبة كلاميّة، فقد يحكي المتكلم ثبوت شيء لشيء، وقد يحكي عدم الثبوت، وليس المراد من الحكاية الثانية ربط ذلك العدم؛ ضرورةَ أنّ العدم عدم في نفسه، ولا يحتاج إلى موضوع يقوم به. فالمراد من النسبة السلبية أنّ الهيئة الكلاميّة تدلّ على نفي شيء عن شيء.
وممّا يرشدك إلى ذلك أنّ القضيّة الحمليّة -سلبيّةً كانت أم إيجابيّةً- لا تختص بالأعراض، بل تجري في غيرها أيضاً، كما في حمل الوجود على الماهيّة أو سلبه عنها في قولك: «الإنسان موجود أو غير موجود»، مع أنّه لا ربط بين الوجود والماهيّة؛ إذ الماهيّة في نفسها لا وجود لها، بل تتحقق بالوجود، فلا يكون عارضًا عليها خارجًا بمعنى وجود شيء لشيء.
وهكذا، قولنا: «زيد إنسان»؛ فإنّ النسبة الكلاميّة فيه وإن كانت موجودة، إلا أنّ النسبة الربطيّة بمعنى أن يكون أحد الوجودين متقوِّمًا بالوجود الآخر غير متحقّقة. وأوضح منه قولنا: «اجتماع النقيضين محال»؛ إذ لا معنى للربط المزبور بين الاستحالة وبين اجتماع النقيضين، وإن كانت النسبة الكلاميّة موجودة؛ إذن فالوجود الرابط منحصر في العرض ومعروضه؛ لأنّ وجوده في نفسه عين وجوده في محلّه، فيتقوّم به خارجًا.
فحاصل كلامه أنّ الجملة السالبة لا تدلّ على اتصاف الموضوع بعدم المحمول، وإنّما تدلّ على سلب اتصافه به؛ لأنّ المحمول عدم محض فلا يعقل اتصاف الموضوع به، وما يدلّ على اتصاف الموضوع بالمحمول إنّما هو الجملة الموجبة؛ فإنّ ثبوت وصف لموضوع عين اتصاف ذلك الموضوع به؛ ولكن يرد عليه: أنّ الموضوع وإن لم يكن يتصف بعدم المحمول في الخارج، لكن يتصف به في عالم الواقع، فالنعوت العدميّة ثابتة في عالم الواقع، ولا يتوقف أخذ هذا الاتصاف موضوعًا للحكم إلى عناية زائدة في قلب عدم العرض إلى حالة وجوديّة تصوّرًا.
والظاهر عدم قلب الموجبة المعدولة المحمول إلى حالة وجوديّة أكثر من لحاظ اتصاف الموضوع فيها بعدم المحمول، فالملحوظ في قولنا: «الإنسان اللا عالم» ليس إلا اتصافه بعدم كونه عالمًا؛ نعم، لا ينبغي الإشكال في أنّ ظاهر جعل السالبة المحصّلة وصفًا -مثل «حجر ليس بأبيض» أو «الحجر الذي ليس بأبيض»- هو كون الموضوع مركّبًا من جزأين: وجود الحجر، وعدم اتصاف بكونه أبيض. واستخدام كلمة «الذي» ليس ظاهرًا عرفًا في أخذ عنوان الاتصاف بعدم كونه أبيض في موضوع الحكم؛ لأنّه يحتاج إلى مؤونة زائدة عرفًا، بل استخدامها لغرض التأليف بين مفردات الكلام، كما هو كذلك في أشباهها.
هذا، وقد ذكر في البحوث وجهًا لامتناع أخذ عدم وصف نعتًا، محصّله أنّه ليس المراد من النعتيّة مجرد إيقاع نسبة ذهنيّة بين مفهومين ولو بنحو لا يكون لها أيّة حكاية عن الواقع والخارج؛ إذ من الواضح أنّه يمكن إيقاعها بين أيّ شيئین، فاتصاف المرأة بعدم القرشيّة في قولنا: «المرأة الموصوفة بعدم القرشيّة» ما لم يثبت كونه مرآة عن واقع لا يكون مانعًا عن جريان استصحاب العدم الأزليّ؛ لأنّه يعتبر مجرد تفنّن في التعبير. ولهذا قد يؤخذ عرض موضوعًا لعرض آخر في الكلام، مع كونهما في عرض واحد، فمثلًا لو قيل: «الغسل بالماء الطاهر مطهِّر» فأخذت طهارة الماء قيدًا في موضوع الغسل؛ حيث أضيف الغسل إلى الماء الطاهر بما هو طاهر، ولكنّه مجرد تفنّن في التعبير، ولا يفهم العرف منه أخذ حيثيّة تقيّد الغسل بطهارة الماء في موضوع الحكم، وإلا لم يكن استصحاب طهارة الماء إلى زمان الغسل قادرًا على إثبات تحقّق هذه الحيثيّة؛ لكونه لازمًا عقليًّا له. كما أنّ النعتيّة ليست بمعنى الوجود الرابط الخارجيّ؛ لعدم ثبوته، بل هي عبارة عن النسبة القائمة في عالم المفاهيم بين العرض ومحلّه، كما في قولنا: «عدالة العالم»، فهذه النسبة تنتزع بلحاظ الاتصاف والربط الثابت بينهما في عالم التقرّر المفهوميّ والماهويّ قبل أن يطرأ عليه الوجود، وإنّما يعرض الوجود على المتصف، أي عدالة العالم، فأخذ أحد جزئي الموضوع نعتًا للآخر، يعني أخذ هذه النسبة بينهما في موضوع الحكم، لا أخذ كلّ منهما بحياله. ولا يرد على هذا التفسير النقض بالأعراض الانتزاعيّة أو الاعتباريّة؛ أمَّا الأولى، فلأنّها أمور واقعيّة ثابتة في عالم الواقع الذي هو أوسع من عالم الوجود، فيكون الربط الواقعيّ بينهما ثابتًا أيضًا، وأمَّا الثانية، فلأنّ الأمر الاعتباريّ، وإن كان نفس المجعول فيه -كطهارة الماء- اعتباريًّا وهميًّا، إلا أنّه في طول لحاظ العرف له واقعًا بنظره الوهميّ يكون الربط بينه وبين الموضوع ثابتًا أيضًا من خلال هذا اللحاظ، فيرى العرف الماء متصفًا بالطهارة.
ولا تعقل النعتيّة بهذا المعنى بين عدم العرض ومحلّه؛ لأنّ عدم العرض ليس له ربط ونسبة واقعيّة مع المحلّ، ولا يتضيّق هذا العدم بلحاظ المحلّ. فحينما نقول: «عدم عدالة العالم» فالمتضيّق ابتداءً هو المعدوم، أي العدالة، فيصير حصّةً من العدالة، ثمّ يفرض عدم هذه الحصّة، وليس المتضيّق هو العدم، بأن يراد عدم مطلق العدالة عدمًا ثابتًا للعالم، وهذا واضح بالوجدان، وقد تسالم عليه الفلاسفة.
ويمكن إقامة البرهان عليه بأن نقول إنّ العدالة إذا كانت مضافة إلى العالم، فنقيضها عدم عدالة العالم، فليس له إطلاق يشمل عدم عدالة الجاهل، فلا يبقى مجال لتضييق هذا العدم مرّة أخرى بإضافته إلى العالم؛ لغرض إخراج عدم عدالة الجاهل عنه. وإن كانت العدالة مطلقة بحيث تشمل عدالة الجاهل، فنقيضها رفعها، وهو عدم واحد، لا عدمان: عدم منتسب إلى العالم وعدم منتسب إلى الجاهل؛ على أنّ المفروض كون المأخوذ عدمه في موضوع الحكم عدالة العالم ولا ربط لعدالة الجاهل به، كما أنّ المأخوذ عدمه في الحكم بالحيض إلى خمسين سنة هو قرشيّة المرأة، لا مطلق القرشيّة الشامل لقرشيّة الرجل، فلا يمكن ذلك إلا بتحصيص القرشيّة بالمرأة في مرتبة سابقة على طروّ العدم عليها.
وهذا يعني امتناع أخذ العدم النعتيّ -بمعنى الاتصاف بعدم العرض- في الموضوع؛ نعم، الأوصاف الوجوديّة الملازمة مع عدم العرض يمكن أن تكون نعتًا للموضوع وإلى ذلك يرجع كلّ ما ثبت من النسبة بين موضوع وعدم عرضه، كقوله تعالى: <بقرة لا فارضٌ ولا بكرٌ> وقوله: «وفدت عليه بغير زادٍ» وهكذا.
ثمّ ذكر وجها استظهاريًّا، وهو أنّ العرف يرى العام بمنزلة المقتضي والخاص الذي خرج عنه بعنوان وجوديّ بمنزلة المانع، ومقتضى ذلك جعل الحكم على هذا النمط طبعًا، بأن يكون موضوعه وجود العام وعدم وجود الخاص، لا أن يؤخذ عنوان زائد، وهو الاتصاف بعدم كونه معنونًا بعنوان خاص في موضوع الحكم، بل ولو فرض الشك فيه، فالاتصاف بالسلب حيث يكون أكثر تقييدًا بالنسبة إلى سلب الاتصاف، فتجري أصالة الإطلاق لنفی هذا التقييد الزائد.
وفيه: ما مرّ من أنّ عدم العرض من حالات الموضوع ونعوته في عالم الواقع، ولا مانع من أخذ اتصافه به في الموضوع، كما في الموجبة المعدولة المحمول. فالمهم هو كون الظاهر من السالبة المحصّلة هو سلب الاتصاف، لا الاتصاف بالسلب. وإن لم يكن ظاهرًا فيه، فلا أصل ينفي أخذ عنوان الاتصاف بالسلب، فكيف تجري أصالة الإطلاق لنفيه خصوصًا مع كون المخصّص متصلًا، بعد أن كان مرجع الأصول اللفظيّة إلى أصالة الظهور؟
هذا، وقد ذكر في البحوث أنّا لو تنزّلنا وتصوّرنا النعتيّة بين عدم العرض والموضوع، فمع ذلك أنّه لا يمنع عن جريان استصحاب العدم الأزليّ فيما إذا كان عدم العرض مضافًا إلى ذات الموضوع، لا إلى الموضوع الموجود في الخارج بما هو موجود. وذلك لأنّ ذات هذه المرأة -مثلًا-، لا المرأة الموجودة بما هي موجودة، كما أنّها لم تكن بقرشيّة قبل وجودها، كذلك تكون لا محالة متّصفة بعدم القرشيّة باتصاف ثابت في عالم الواقع الأوسع من عالم الوجود، وهذا لا ينافي ما يقال من أنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له؛ فإنّه تابع للعالم الذي ثبت فيه شيء لشيء؛ فإنّه يلزم ثبوت المثبت له في ذلك العالم، فلو كانت النعتيّة والنسبة بين عدم العرض والمحلّ ثابتًا، فلا محالة يكون ثابتًا في عالم أسبق من عالم الوجود؛ لصدق عدم قرشيّة المرأة قبل وجودها.
وفيه: أنّ المتصف بالأوصاف اللازمة للفرد إن كان وجود الفرد، فالفرد قبل وجوده لم يكن متصفًا بها، فالجدار قبل وجوده لم يكن متصفًا بعدم البياض، وإن كان المتصف ذات الفرد، فذات الفرد تتضمّن أوصافها اللازمة، فذات المرأة القرشيّة قرشيّة، وذات الرجل الأمويّ أمويّ.
ثمّ إنّه ممّا ذكرناه تبيّن الإشكال فيما ذكر في تهذيب الأصول في مقام إنكار استصحاب العدم الأزليّ من أنّ السالبة المحصّلة، حيث تصدق بلا وجود موضوعها، فلا يمكن أن تكون قيدًا لموضوع حكم وجوديّ؛ فإنّه لا يعقل جعل الحكم الوجوديّ على العالم مسلوبًا عنه الفسق بالسلب التحصيليّ الذي يصدق بلا وجود للعالم، بل لا بدّ أن يكون القيد العدميّ إمّا بنحو الموجبة المعدولة، مثل «المرأة اللا قرشيّة» أو «المرأة غير القرشيّة»، ومن الواضح أنّها بحاجة إلى وجود الموضوع، فيكون قيد الموضوع هو اتصاف المرأة بأنّها لا قرشيّة أو غير قرشيّة، أو يكون القيد العدميّ بنحو الموجبة السالبة المحمول، وهي كما يقال زيد هو الذي ليس بقائم، فيكون الموضوع -مثلًا- «المرأة التي ليست بقرشيّة». وهذا يحتاج إلى وجود الموضوع أيضًا، فيكون قيد الموضوع «التي ليست بقرشيّة»، أي اتصاف المرأة بأنّها ليست بقرشيّة. واستصحاب عدم القرشيّة بنحو السالبة المحصّلة لا يثبت اتصاف المرأة بذلك، بل لو قال المولى: «أكرم العالم الذي ليس بفاسق»، واتصاف زيد بعدم الفسق في زمان كونه عالمًا، فاستصحاب عدم فسقه قبل ذلك لا يثبت اتصاف العالم بعدم كونه فاسقًا؛ فإنّه يرد على ما ذكره -من أنّ مقتضى تعنون العام هو أخذ الاتصاف بعدم معنونًا بعنوان الخاص- أنّ احتمال كون القيد هو الموجبة المعدولة خلاف الظاهر جدًّا، بل المستظهر عرفًا هو كون القيد السالبة المحصّلة، خصوصًا إذا كان المخصّص متصلًا؛ فإنّ الظاهر من «المرأة التي ليست بقرشيّة» أو «كلّ امرأة ليست قرشيّة» هو كون السالبة المحصّلة قيدًا في الموضوع. وإنّما جيء بالموصول في الأوّل أو استخدمت هيئة الجملة الوصفيّة في الثاني للربط الكلاميّ بين مفردات الجملة، من دون أن يراد أخذ حيثيّة الاتصاف بالعدم في الموضوع بعد أن كانت هذه الحيثيّة انتزاعيّة، لا واقع لها في الخارج.
وهذا النحو من الربط الكلاميّ موجود حتى في أخذ جوهرين أو عرضين موضوعًا للحكم، كقولنا: «إذا جاء زيد ولم يجئ عمرو فافعل كذا». وما ذكره من أنّ استصحاب عدم فسق زيد قبل أن يصير عالمًا لا يثبت اتصاف العالم بعدم الفسق، فلا يثبت موضوع قوله: «أكرم العالم الذي ليس بفاسق»، فلا يخلو من غرابة؛ فإنّه لا يظهر منه أخذ عنوان اتصاف العالم بعدم الفسق في الموضوع، بل الظاهر منه عرفًا أنّ موضوع الحكم مركّب من جزأين: أحدهما أن يكون شخص عالمًا، وثانيهما أن لا يكون فاسقًا، والجزء الأول محرز بالوجدان والثاني بالاستصحاب.
وأمّا ما ذكره من أنّه لا يمكن أن تكون السالبة بانتفاء الموضوع أو الأعم منه ومن السالبة بانتفاء المحمول جزءًا للحكم الوجوديّ، إذ لا معنى لتعلّق الحكم بالمعدوم، فتبقى السالبة بانتفاء المحمول وليست لها حالة سابقة متيقّنة، ففيه: أنّ الموضوع بعد أن كان وجوديّا فأيّ مانع من أن يكون قيده سلب الاتصاف بنحو السالبة الأعم؛ نعم، كون الظاهر من السالبة هو السالبة بانتفاء المحمول واضح، إلا أنّ الكلام في أنّها هل هي قضيّة بسيطة مباينة عرفًا مع السالبة بانتفاء الموضوع أم أنّها قضيّة مركّبة من فرض وجود الموضوع وسلب شيء عنه، فالأول ثبت بالوجدان والثاني يثبت بالاستصحاب.
وأمّا ما مرّ منه -من أنّ القول بأنّ هذه المرأة قبل وجودها لم تكن هذه المرأة، فالسالبة المحصّلة بانتفاء الموضوع التي تعني عدم كونها قرشيّة قبل وجودها وسلب القرشية عنها قبل وجودها قول كاذب- فقد قلنا بأنّه خلاف الوجدان العرفيّ؛ فإنّه بعد وجود هذه المرأة يمكن الإشارة إليها، ولذا لا إشكال في الإخبار عن عدم وجود هذه المرأة سابقًا بنحو مفاد «ليس» التامة والتي تدلّ على سلب الوجود عن ماهيّة، فيمكن الإخبار أيضًا عن أنّها لم تكن قرشيّة قبل وجودها، وهكذا في سائر عوارض الوجود، فيقال -مثلًا- هذا الحجر لم يكن موجودًا سابقًا، فلم يكن أسود ولا أبيض.
كلّ ما ذكرناه إلى الآن في الإشكال على المقدّمة الثالثة كان مبنيًّا على تفسير العدم النعتيّ بالاتصاف بالسلب، وتفسير العدم المحموليّ بسلب الاتصاف، ولكن لو فسّرنا العدم المحموليّ بمفاد «ليس» التامّة، أي نفي ثبوت العرض عن محلّه، بأن يكون الموضوع -مثلًا- وجود الحجر وعدم وجود البياض له، وفسّرنا العدم النعتيّ بمفاد «ليس» الناقصة، بأن يكون الموضوع -مثلًا- وجود الحجر وعدم كونه أبيض، فلا إشكال في أنّ ظاهر الدليل هو أخذ العدم النعتيّ، وأوضح منه لو فسّرنا العدم النعتيّ بعدم العرض المضاف إلى محلّه وفسّرنا العدم المحموليّ بعدم العرض في حدّ نفسه.
ثمّ لا يخفى أنّ المحقق النائينيّ؟ق؟ وإن التزم بجريان استصحاب العدم الأزليّ في العدم المحموليّ، كقولنا: «إذا وجد حجر ولم يوجد بياض معه»، لكنّه ادّعى أنّه حتى ولو ورد هذا التعبير في الخطاب، فمقتضى البرهان تقيّده بالعدم النعتيّ؛ لأنّ إطلاق الجزء الأوّل، وهو الحجر لفرض كونه أبيض، موجب لتهافته مع الجزء الثاني؛ فالإطلاق غير معقول، كما أنّ الإهمال من الحاكم الملتفت غير معقول. فيتعيّن تقييده بعدم كونه أسود، وحينئذٍ يأتي ما سبق منه من كون إثباته بالعدم المحموليّ من الأصل المثبت.